

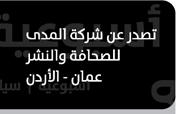
من دمشق إلى جامعة توبِنغن في ألمانيا, ثم إلى أكسفورد ، ومنهما إلى التدريس في جامعات عربية وأخرى عالمية, منها الجامعة الأميركية في بيروت, وجامعة إكستر في إنكلترا وبودابست في هنغاريا. وبين هذه وتلك، نشر «عزيز العظمة» سلسلة مؤلفات ما زالت أصداء وتداعيات بعضها تتردد وتتفاعل في الأوساط الفكرية والثقافية العربية. ومن أعماله: «التراث بين السلطان والتاريخ»، «الإسلام والحداثة»، «العلمنة من منظور مختلف»، «الكتابة التاريخية»، «ابن خلدون وتاريخيته»، «العرب والبرابرة»،»الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية»،»دنيا الدين في حاضر العرب» ، و سلسلة نصوص تراثية مع مقدمات نقدية عن الماوردي، ابن تيمية، ابن الراوندي، ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم.
السّجل: بدأتَ بالفلسفة وتحولت إلى التاريخ، فكيف استفاد المؤرخ من الفيلسوف؟
لولا بدايتي الفلسفية لما كنتُ قادراً على الإلمام بمفهوم «العموم» في التاريخ مثلاً، أي البحث عن الأمور المشتركة بين التواريخ المختلفة. وقد علمتني الفلسفة أن أدقق النظر في العلاقة بين العام وبين الخاص، وأن أنظر إلى الزمن الذي مكنني من رؤية جملة من التشابهات. لأن الفلسفة في نهاية المطاف هي ممارسة للتفكير المُمَنهج. وقد اتخذتُ اتجاه التاريخ، لأسبابٍ هي في معظمها عامة. فنحن نعيش في منطقة من العالم ليست مشبعة بالتاريخ فحسب، وإنما هي أيضاً مهووسة بالتاريخ. فرأيت أن عليَّ النظر العلمي في أمور التاريخ. وبدأت بالعمل حول «ابن خلدون». وكان اتجاهي الأساسي هو نفي صفة الحداثة عنه. لأن نسبة صفة الحداثة لابن خلدون تجعلنا ندخل في مجال لا تاريخي؛ وذلك بإسقاط أمور حديثة على أمور تنتمي لعصر آخر. وأنا ضد اختلاط الأزمنة والعصور. العمل التاريخي يعني، بالنسبة لي، ممارسة عقلية متجردة قدر الإمكان من أهواء اليوم. كما ترمي إلى إضفاء الصفة التاريخية أي الماضوية على جملة من الأمور، وإلى النظر في قطاعات التاريخ وإلى تحولاته. وبهذا المعنى، فأنا مؤرخ لأنني مراقب للتحوُّل ولستُ مراقباً للثبات.
السّجل: وما الخطأ في استعادة الماضي؟
ع. ع. الخطأ ليس في استحضار الماضي، بل في محاولة استنساخه. إن تفسير الحاضر بواسطة الماضي إجحاف بحق الواقع الآني وبحق التاريخ. والعديد من المشكلات التي تواجهنا اليوم، على اختلاف صياغاتها الأيديولوجية والخطابية، تعود إلى هذا الخلط بين الأزمنة، وإلى توهم ماضٍ لم يكن قائماً، وإلى توهم مستقبل مشتق من الماضي، والعودة للمنابع وهمٌ لتحشيد عواطف الناس. فالصورة المنسوبة إلى هذا الماضي الذهبي، منسوجة على منوال مستقبل مأمول. وهذا المستقبل له توصيف سياسي واجتماعي وثقافي بالغ التعيين، وبالغ في المحافظة، وهو توصيف شمولي في الشكل السياسي الذي يرتجيه. ولذلك نرى كيف أن المادة المستقاة من الماضي، تُستخدم على شكل رمزي، لاستدعاء عواطف الناس في وصف صورة لمجتمع منشود هو، في جوهره، نتيجة لمشروع سياسي أصولي معلوم. وقد آن لنا أن نقلع عن التوهم بأن ما كان صالحاً ومحموداً في القرن الرابع عشر، سيبقى كذلك في القرن الواحد والعشرين. وعلينا أن نكف عن التفاخر بالفرادة في التاريخ. فالتاريخ تحكمه جملة من القوانين تصدق على جميع المجتمعات.
السّجل: وهل استطعت أن تنهج نهجا مميزا لكتابة التاريخ العربي الإسلامي؟
ع. ع. إنْ كنتُ قد أحدثتُ انقلاباً في كتابة التاريخ، فهذا أمر عائد لتقدير الآخرين. فهناك تواريخ في الفترة الكلاسيكية من الفكر العربي. وهناك مفهوم للتاريخ على أنه سجل للأحداث مرتبة وفقاً لتسلسل الزمن. وهي غالباً أحداث تتعلق بأخبار الدولة. كما أن ثمة تاريخا آخر، هو التاريخ الإلهي، أي التاريخ البشري بوصفه تجلياً للإله. وهو تاريخ صعود وتاريخ هبوط، وتاريخ خلق ونبوة ثم هبوط، ثم نبوة أخرى ثم هبوط، ثم نبوة أخيرة هي نبوة محمد، ثم هبوط ونهاية الزمان. وهذه نظرة دائرية يكون فيها للتاريخ مبتدأ واحدا هو الخلق أو السقوط، ومنتهى واحد هو القيامة. أما أنا، فلا يصدر موقفي عن مفهوم غائي للتاريخ، بل بالأحرى عن قراءة للعمليات التاريخية العالمية والموضوعية. وترتبط هذه العمليات بموقع مركزي من الوجهة المعرفية يشغله العلم؛ علوم الطبيعة والتاريخ والاجتماع. كما يرتبط بها تهميش وجهيْ الدين: السياسي والعام، وكذلك تهميش المؤسسات الدينية أو قصرها على تأدية وظائف خاصة.
السّجل: يبدو أنك تعتبر الدين هو المشكلة، وتتحدث مرارا عن تهميش الدين بوصفه أبرز تعبيرات العلمانية. أي موقع تحتفظ به للدين في الحياة العامة في العالم العربي؟
ع. ع. ليس الدين بذاته هو المشكلة. فالمشكلة هي تطور المجتمع أو احتباسه أو نكوصه. المشكلة هي تسييس الدين، وتتمثل في قوى سياسية، مدمرة تاريخيا، تعبئ الناس حولها باسم الدين. وفي المقابل، فإن من شأن النظام العلماني أن يجعل من الإيمان الديني وطقوسه شأناً خاصاً. إن تحولات التعبيرات والمؤسسات الدينية تعقبان حركة المجتمع ولا تسبقانه. وليس ثمة إصلاح ديني مستدام إلاّ بتنمية ثقافية واجتماعية فيها مقومات الاستمرار. وفي نهاية المطاف، ليس الدين ومؤسساته هو ما يصلح من شأن الدين عموماً: الإصلاح الديني يُفهم على أنه عودة ارتكاسية إلى أصول، بينما نجد في الواقع التاريخي، أن ما أصلح الدين (وأتكلم هنا عن المسيحيين، وعن الإسلام حتى السبعينات، والثمانينات في القرن الماضي) هو رقي المجتمع. واتساع هذا الرقي هو الذي يرغم المؤسسة الدينية وفكرها على الإصلاح.
السّجل: في قراءتك – وكتابتك – للتاريخ العربي، هل ثمة خطوط أو نقاط يتوازى فيها منهجك الفكري أو يلتقي مع آخرين، ، و أين تتقاطع معهم وأين تختلف؟
ع. ع. في إجابة مختصرة، يتقاطع خطابي بشكل دقيق جداً مع « عبد الله العروي «، وهذا أمرٌ معروف للاثنين. كما أتقاطع في بعض الأمور مع « محمد أركون « وغيره. أما على الصعيد النظري والمنهجي العام، فإنني مدين لفلاسفة التاريخ الأوائل والأهم: «هيغل» و» هاربر « و «ماركس « وغيرهم، ممن كتبوا سرداً تاريخياً أصبح الأساس في كل الكتابات التاريخية اللاحقة. وجميع قواعد السرد المعين لروايات تاريخية معينة، أو لتاريخ العالم جملةً، هي في الواقع وحتى يومنا هذا، من صناعات «هيغل». أما «فوكو»، فقد تداخل عمله الفلسفي في عمله التاريخي، ففلسف وأرَّخ وأعاد الاعتبار للمهمش والمقصي الذي لا ينتمي للأحداث الكبرى كالجنون والسجن، كما أحدث تحولات أساسية في النظر إلى التاريخ، خصوصاً مع مفهوم بالغ الأهمية، وهو مفهوم الانقطاع بين الفترات التاريخية المختلفة. فالذي صنعه فوكو، والذي أحاول أن أصنعه أنا أيضاً، ولكن من منطلقات مغايرة بعض الشيء، هو أن أرى في كل عصر جملة من المفاهيم الحاكمة، التي تفرض نمطاً معيناً من التفكير والسلوك. وبالطبع، هذا لا يلغي القول بوجود هوامش، ولكن هناك دوماً حركة متسلسلة مركزية، تتمحور حولها التحولات المختلفة. وقد يكون لهذه التحولات آثار بعيدة الأمد، وقد لا يكون.
السّجل: كثيرا ما اتهمت بأنك تدعو إلى إحلال العلمانية مكان الدين؟
ع. ع. لا مجال للتفكير بعالم خالٍ من الدين. وأنا لا أرى في العلمانية دينا على الإطلاق، بل هي نوع من الإدراك و الصيرورة الاجتماعية و المعرفة الموضوعية. ومن جهة أخرى، لا ألزم اشتراطا بين العلمانية والديمقراطية, فهناك دول علمانية غير ديمقراطية, ودول علمانية ديمقراطية, إنما ليس هناك دول دينية ديمقراطية, وإن تزيت العملية السياسية فيها ببعض شكليات الديمقراطية. والمشكلة لا يمكن أن توضع في سياق فصل الدين عن الدولة، بل فصله عن تعريف الهوية السياسية للمواطن، فصله عن القانون والدستور والسلوك الاجتماعي والعلمانية لا تقوم على استيراد للنماذج من هنا وهناك. بل هي عملية موضوعية متعينة في التاريخ, و بالتالي فإن التحولات العلمانية, بما تشمل من تحولات في نظم التعليم والمعرفة, والنظم القانونية الخ؛ تتخذ أشكالا مختلفة باختلاف الظروف. والعلمانية ليست وصفة، وليست قائمة فروض، بل عملية تاريخية موضوعية في سياق عالمي. وعلى القوى المدنية أن تتولى قيادة تلك العملية التاريخية. عليها التحدث والعمل من أجل القضايا المرتبطة بعلمانية الدولة، ومناهضة العصبوية والطائفية، وفصل الدين عن الدولة، ومن أجل سيادة القانون التي تقتضي الضرورة أن يكون قانوناً مدنياً، دون أن يكون قانون استثناء وطوارئ، قانونا مرتبطاً بتوسيع الحريات المدنية والسياسية، قانوناً مدنياً موضوعاً للبشر، ولا يدعي التحدث باسم الإرادة الإلهية، ولا ينتقص من المساواة التامة بين المواطنين ولا من حرياتهم الشخصية، ولا يملي على المرأة زياً ترتديه.
السّجل: كنت، منذ سنين، قد رفعت شعار: (لنتكلم علي سجيتنا ولا نخاف أبدا!). وهي عبارة توحي بأن عصر الحريات العربية لابد أن ينفتح بعد أن أغلق دهرا طويلا في النواحي الفكرية والسياسية والنقدية. فأين أنت من شؤون بلدك السياسية، وبخاصة في قضايا الحريات وحكم القانون والمجتمع المدني وحقوق الإنسان؟
ع. ع. أنا لا أقدم إجابات سريعة للقضايا المطروحة، ولا أتملق أي جمهور، اللهم إلا في نقاشات أتولى فيها دور محامي الشيطان، ثم أنهي اللعبة. لكنني، في المجمل، قررت منذ ثلاثين عاماً أن أنأى بنفسي عن الانشغال المباشر بالسياسة. وحزمت أمري على توجيه ما يولده اهتمامي بالشؤون العامة لدي من قدرات نحو العمل الثقافي والعلمي.
| مؤرخ لا كالمؤرخين – أجرى اللقاء د. فايز صياغ |
| 15-Nov-2007 |
| العدد 2 |