

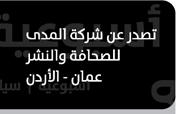
موفق ملكاوي
ليس هناك فاصل يمكن تلمسه بين ما هو إنساني وما هو شعري لديه، فقد اندمج الجانبان ليكوّنا شخصيته: محبوب من كثيرين، ومبغوض من آخرين رأوا أنه تحول عن نهج كاد يتميز به عندما كان في أوائل الشباب.
ألقابه عديدة، فهو الشاعر والسفير والوزير، إضافة إلى ألقاب أقل بريقاً، إلا أن حيدر محمود في كلها كان هو نفسه، متتبعاً حدسه الذي قاده دائماً إلى بر الأمان، رغم معارك كثيرة خاضها.
ولد في بلدة الطيرة قضاء حيفا في فلسطين المحتلة العام 1942. نزحت أسرته ولجأت إلى مخيم الكرامة في الأردن، حيث تلقى بداية تعليمه.
موهبته الشعرية، أخذت بالتبدي في سن مبكرة. يقول: «كان الشعر مزيجاً من الاحتجاج على اغتيال الفرح، ومحاولة رجولية لتخطي المسافة بين الجرح وبين البندقية التي كانت بعيدة جدا عني».
انتقلت الأسرة إلى مدينة عمان، وهناك واصل تعليمه في (كلية الحسين) إلى أن نال شهادة الثانوية العامة، حيث زامل هناك طاهر حكمت، والشاعر تيسير سبول.
يأسى كثيراً عندما يتذكر أن الجامع الأول الذي صلى فيه طفلا، جامع الطيرة، «أصبح ملهى ليلي.. كابريه لليهود».
بداياته في نشر قصائده كانت بوساطة الراحل إبراهيم سكجها، سكرتير تحرير صحيفة «فلسطين» آنذاك، وكان في السابعة عشرة حينها، وبعد أعوام قليلة عمل سكرتيراً لتحرير صحيفة «الجهاد». وكلتاهما كانت تصدر في القدس أيام وحدة الضفتين.
يتذكر أن أولى قصائده الغزلية كانت من نصيب جارته. يعترف بأنه لا يتوقف كثيراً عند شعر الغزل، فهو يكتب للحياة المفتوحة على مصراعيها.
اتجه إلى العمل الصحفي، وبقي فيه زهاء سبعة أعوام، ثم انعطف إلى العمل الإذاعي، وهناك أرسله رئيس الوزراء الأسبق الراحل وصفي التل، إلى بريطانيا، فنال بكالوريوس إعلام في ستينيات القرن الماضي.
في تلك الأثناء كانت قصائده تتوالى، متغنياً بعمان، والمدن الأردنية، والفلسطينية. ولعل ما كرّس شهرته هو غناء نجمتين لقصائده: نجاة الصغيرة، وماجدة الرومي.
في نهاية السبعينيات، عندما كان يعمل مذيعاً في تلفزيون في دبي، حنّ إلى عمان، فكتب قصيدته «المتنبي يبحث عن سيف الدولة» ونشرها في صحيفة «الرأي»، ما حدا بالملك الراحل الحسين بن طلال، إلى الإيعاز لرئيس الوزراء وقتها مضر بدران بإعادة حيدر إلى عمان.
في اليوم التالي كان في عمان، وعين مديراً عاماً لدائرة الثقافة، وهو المنصب الذي بقي فيه زهاء ثمانية أعوام.
في العام 1989، كتب قصيدة «عرارية» بعنوان: «نشيد الصعاليك»، تزامنت مع «هبّة نيسان»، يقول فيها:
«عفا الصفا وانتفى يا مصطفى وعلت
ظهور خير المطايا شر فرسان
فلا تلم شعبك المقهور إن وقعت
عيناك فيه على مليون سكران».
القصيدة على ما يبدو أثارت حفيظة مرجعية حكومية كبيرة، مع أن حيدر محمود أنكر أن تكون موجهة إليها، فتم عزل الرجل وتجريده من امتيازاته الوظيفية.
عودته إلى الأضواء لم تتأخر كثيراً، وهذه المرة أختبر وظيفة جديدة، فقد تم تعيينه سفيراً للأردن في تونس، وهي التجربة التي يقول إنها أثرت فيه كثيراً، حتى تبدى ذلك في أشعاره اللاحقة كما يرى نقاد أردنيون.
روح الشاعر لم تفارقه، حتى وهو يمارس أرفع الأعمال الدبلوماسية، فالشعر، والسفارة، لديه لا ينفصلان، خصوصاً أنه يعيد الوظيفة إلى ما كانت عليه عند العرب القدماء، «كان الشعراء في الجاهلية الأولى شعراء قبائلهم لدى القبائل الأخرى، ليس غريباً أن يكون الشاعر سفيراً لقبيلته، وبالتالي لبلده».
ويضيف: «مجال التناقض الوحيد أن الشاعر عندما يريد أن يقول شعراً يتجاوز كل حدود الدبلوماسية، وكل حدود المألوف».
لهذا كله تخطى الديبلوماسية حين استأذن الدولة التونسية في أن يقدم إلى ضريح أبو القاسم الشابي في «توزر» أوراق اعتماده كشاعر، بعد أن قدمها كسفير إلى رئيس الدولة.
موعده مع الوزارة كان من خلال حكومة علي أبو الراغب، التي شغل فيها منصب وزير الثقافة. وفي الوقت الذي استبشر فيه مثقفون بتسلّم واحد منهم أعلى المناصب الثقافية في البلد، كانت خيبة الظن بحسب بعضهم، ممن رأوا أن الوظيفة طغت على الجانب الإبداعي عند الرجل، وأنه لم يقدم الكثير إلى الوسط الثقافي.
الخروج من الوزارة لم يتبعه خروج من الحياة العامة، فقد تولى بعدها بقليل إدارة مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان، لكن المشاكسة التي يختزنها الرجل في جوانيته أفرزت قصيدة أخرى، كادت أن تنهي مشواره مع الوظيفة العامة، حين كتب قصيدة «السرايا»، التي وجهها إلى الملك عبدالله الثاني شاكياً الحكومة آنذاك، وكانت تشتمل على انتقادات كثيرة، وعدّها بعضهم «قاسية»:
«يا سرايا نشكو إليك السرايا ونناديك باسم كل القرايا
فلقد أخطأت كثيراً كثيراً لتصير الأخطاء فيها خطايا
شوهت وجهنا الجميل الذي كا ن مثال الجمال بين البرايا
واستباحت دموعنا، ودمانا واستزادت علي الرزايا رزايا!».
القصيدة التي نشرتها «القدس العربي» اللندنية، كانت سبباً في استقالة أخرى قدمها من منصبه مديراً عاماً لمركز الحسين الثقافي.
حينها قال حيدر إنه تقدّم باستقالته لأمين عمان المهندس نضال الحديد، «منعاً للإحراج».
حياة الكرّ والفرّ.. القمة والقاع، اختبرها الرجل كثيراً، واعتاد عليها، حتى إنه لم يعد يخشاها، فبعد وقت قصير سيعيد اعتباره ويعود مرة أخرى إلى أمانة عمان، مشرفاً على الملف الثقافي فيها برمته.
العلاقة الأقرب إلى قلبه، تظل دائماً علاقته بالراحل الحسين بن طلال، فهو يصرّح «هواي هاشمي».
يعتبر أن ما كان بينه وبين الملك الحسين هو «علاقة عشق صوفية». ويؤكد «أنا واحد من الذين حزنوا أكثر من غيرهم في كل الدنيا على فقد الحسين»، مبيناً أنه «لم يكن ملكاً فقط، كان إنساناً كبيراً، وكان قريباً من كل الناس، وهو غيَّر مسار الملوك في كل تاريخهم».
العاصفة الأخرى التي يتذكرها العرب جميعهم، والتي أثارها اسم حيدر محمود، كانت غداة العدوان الأميركي على العراق في آذار العام 2003، عندما ظهر صدام حسين على شاشة التلفزيون وقرأ قصيدة حماسية، نسبها بعضهم إلى حيدر محمود.
حيدر يعترف بأن علاقته بصدام «كانت ممتازة، ولي صور معه»، وأنه «كان يأتي ويحضر لي بعض الأمسيات»، نفى بشكل قاطع أن تكون القصيدة له، أو أن تكون مصاغة بالأسلوب الذي عرف به الشاعر.رغم هذا النفي، هناك حتى اليوم من يقول إن القصيدة لحيدر، وإنه حاول نفيها عنه لأسباب تتعلق بالمرحلة التي كانت تمر بها المنطقة.
حيدر الشاعر، الذي يكتب دواوينه بخط يده، ليتفادى وقوع أخطاء طباعية، يقول: «إن الشعر بسيط مثل الخبز، عميق مثل الحزن، رحيب»، وهو ينتقل بين الشكل الكلاسيكي والشكل الحديث، واثقاً من نفسه ذلك بسبب لغة طوّعها بمهارة.
يصفه الناقد سمير قطامي، إنه «وطني حد التصوف، قومي حد الحلول، إنساني حد التسامي، وإنسانيته تبدأ من دائرة تعلقه بوطنه الصغير فلسطين والأردن، ثم بوطنه الكبير، وأمته التي جار عليها الزمن».
في حياته الأسرية يعتبر نفسه تقليدياً جداً، وأن زواجه كان عادياً جداً، وهو الأب لولدين وبنتين.
جوائز عديدة تحصل عليها، فقد تقاسم مع الشاعر التونسي يوسف رزوقة، جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع الشعري. وحاز جائزة ابن خفاجة الأندلسي الإسبانية، وجائزة الدولة التقديرية في الأردن، كما نال وسام الاستحقاق الثقافي من تونس.
| حيدر محمود: الشعر، السفارة، والوزارة مُلكُ يديه |
| 16-Apr-2009 |
| العدد 72 |