

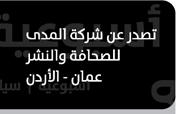
عرفت الثقافة العربية، في القرنين التاسع عشر والعشرين، جهوداً فكرية متلاحقة، أخذت بتصورات حديثة، اعترفت بالعقل ووظيفته النقدية، وباختلاف أسئلة الحاضر عن الماضي، وبضرورة الانفتاح على المعارف والتجارب الإنسانية الكونية. وتطلّعت هذه الثقافة إلى حداثة عربيّة، تتأسس على الديمقراطية والمجتمع المدني والاستقلال الوطني وتحرر المرأة والحوار المجتمعي، بعيداً عن التعصب والأفكار الجاهزة.
فيصل دراج
انطوت حياة الروائي عبد الرحمن منيف (1933 - 2004) على ثلاثة أبعاد جديرة بالتأمل، البعد الأول: المثقف والسياسي، ذلك أن منيف بدأ حياته مناضلاً سياسياً متحزّباً، رأى في انتصار حزبه انتصاراً لأحلامه، إلى أن أخبرته التجربة أن السياسي يناضل من أجل مصلحته، ويرمي بالمثقفين الحالمين إلى غياهب السجون.
يظهر البعد الثاني في: المثقف - السياسي الذي يحتفظ بحلمه ويذهب إلى الكتابة، مقترحاً على قارئه أن يبتعد عن الأحزاب السلطوية. صنعَ هذا الاختيار من عبد الرحمن منيف روائياً يعهد إلى روايته بأن تقوم بما كان على الحزب المفترض أن يقوم به. يتراءى البعد الثالث في انتساب الروائي السعودي، قيماً وأفكاراً وممارسة، إلى جيل التنويريين العرب، الذين آمنوا بأن الكلمة الصائبة تقاوم سلطة الخراب.
أنتج منيف رواية سياسية بمعنى مزدوج: أولهما بسيط يربط بين الرواية والحديث عن السجن والنفط والاستعمار، وثانيهما، وهو أكثر عمقاً وإبداعاً، يصدر عن «عنصرين أدبيين» هما: اللغة والمادة الحكائية. فقد أخذ الروائي في كتابته بما دعاه: «اللغة الوسطى» التي تتيح للروائي أن يعبّر عما يريد بوضوح وبساطة، وتسمح للقارئ أن يدرك مقاصد الكاتب من دون مشقة. لا تترجم هذه اللغة تقنية أدبية قوامها الوضوح والبساطة فحسْب، إنما تترجم أولاً نزوعاً ديمقراطياً قوامه الاعتراف المتبادَل بين الكاتب والقارئ.
أراد الروائي وهو يجمع مادته الحكائية، وهنا العنصر الثاني، أن يعطي صوته لهؤلاء الذين لا يحسنون الكتابة، فكتب عن قضاياهم وأذاب صوته في أصواتهم. وما الحشود الهائلة التي أدرجها في عمليه الكبيرين «مدن الملح» و«أرض السواد» إلا برهان على تصور ديمقراطي، يحتفي بالبسطاء المجهولين، ولا يكترث بـ«الأبطال» ومشاهير الرجال.
درس منيف الواقع العربي قبل أن يكتب عنه، وعرف الممارسات السلطوية قبل أن يحوّلها إلى متواليات روائية. ولهذا تحدث عن «السياسة الأمّية والمتقلبة التي تغمر الساحة العربية من أقصاها إلى أقصاها»، وعن «سيطرة نمط من السياسيين الذين يتصفون بالتشاطر والقسوة الانتهازية، وصولاً إلى الانحطاط والخسّة في آن واحد». وضع في كلامه غضباً واسعاً، لأنه انتمى إلى جيل هزّه «سقوط فلسطين»، وبحث عن «حزب جديد» يهزم إسرائيل، إلى أن أدرك أن «السلطات الجديدة» تهزم المجتمعات العربية لا غيرها. لا غرابة أن يرى منيف في الحرية موضوعاً أساسياً لأعماله، وأن يلجأ إلى جميع ألوان الكتابة للدفاع عن أفكاره: الرواية، والقصة القصيرة، والمقالة، والسيرة، والدراسة التاريخية...
تضمنت رواية منيف، روايتين: رواية مضمرة تسرد سيرته الذاتية الفكرية، التي احتشدت فيها مراحل الحلم والخيبة والتمرد، ورواية معلنة تسرد أسباب قهره ولواذه بالكتابة الروائية. وواقع الأمر أن رواية «شرق المتوسط» (1975) التي طُبعت أكثر من اثنتي عشرة مرة، لا تندد بقمع سلطوي غير مسبوق، بقدر ما تحتجّ على «مآل قومي» وعدَ بالحرية، ذات مرة، وانتهى إلى الخراب. فقد وصفت «صناعةَ الإذعان» التي تدفع بالرأي الحر إلى السجن وتجعل المجتمع كله سجناً واسعاً، يتعايش مع استقرار لا يختلف عن «استقرار القبور».
هذا الهاجس الذي أرّق منيف طويلاً دفعه إلى إعادة كتابة روايته بعنوان جديد: «الآن.. هنا، أو شرق المتوسط مرة أخرى» (1991)، التي رصدت تزايد القمع في مجتمع عربي يسير إلى التداعي.
كتب منيف في «شرق المتوسط» عن سجن مزدوج: السجن الصغير الذي يدور فيه الجلاد والضحيّة، والسجن الكبير المتمثّل في ملايين البشر الذين سُلبوا حق الكلام. استولد من الحرية المحرّمة بداهة الهزيمة وكتب «حين تركنا الجسر» (1976) التي تتصادى فيها أصوات هزيمة حزيران 1967، معتمداً على مجاز «الخصاء»، الذي هو سبب للهزيمة وشرط لاستمرار السلطة القامعة. بيد أن الرعب لا يتمثل في مجاز العقم وخسارة المعركة، بل في ذلك الخراب الروحي الشامل الذي يستوطن المهزوم «الذي لم يقاتل».
أما في روايته «النهايات» (1977)، فقد واجه دنسَ السلطة بنقاء الصحراء، مبيّناً أن السلطة تغتال الطبيعة والمجتمع معاً، فهي لا تعرف الاعتدال ولا الحاجات العقلانية، لأن ولعها بالكمّ يُملي عليها أن تصطاد ما تحتاجه، وتطلق النار على ما لا تحتاجه.
جعل منيف من رواياته، التي جمعت بين الواقع والمتخيّل، تشريحاً دقيقاً للسلطة في العالم العربي، فكشف عن معنى «الحر الوحيد» في مجتمع للعبيد، بلغة الفيلسوف الألماني هيغل، وعن عبادة الكمّ التي تميّز السلطات المتخلّفة، وعن أمراض المستبد الذي يرى في شعبه عدوَّهُ الوحيد. أراد وهو يتأمل «عبادة الكمّ» في روايته «مدن الملح»، أن يدلل على كراهية الأنظمة المتخلّفة لمعنى «الكيف»، الذي يحيل على الثقافة والفنون والأرواح المهذّبة. لم يكتب عبد الرحمن منيف، بهذا المعنى، رواية سياسية بالمعنى الفقير للكلمة، ولم يكن رائداً في «رواية السجون» فقط، بل قدّم منظوراً سياسياً للكتابة الروائية، يخبر عن المظاهر التسلطية ويكشف عن السببية الداخلية، التي تدفع بـ«الدولة التسلطية» إلى القهر والفساد والإفساد.
لعل هذه السببية الداخلية هي التي دعته إلى كتابة «مدن الملح»، في أجزائها الخمسة، حيث السلطة التابعة لا توطّد مواقعها إلا إذا ألغت المجتمع، متوسلةً نشر الوعي الزائف والاستعمال السلطوي للدين، ومستعينة بألوان من المثقفين يقايضون الحقيقة بالمصلحة.
قدّم الروائي في عمله الكبير درساً في العلاقة بين الرواية والمعرفة، وبرهن أن المعرفة الروائية معرفة موضوعية، تشرّح عن طريق المتخيّل العادات والعقائد وتكوّن الأجهزة السلطوية. مارس الكاتب على طريقته، سياسة الكتابة التنويرية، التي ميّزت بين التعويض والتحريض. ذلك أن الكتابة التعويضية، وهي كتابة سلطوية في التحديد الأخير، تعطي القارئ النصر الذي يرغب به دون أن يشارك في شيء، على خلاف الكتابة التحريضية التي تجعل من القارئ شريكاً للكاتب، يقاسمه البحث والقلق والاحتجاج. وإذا كان التنويريون العرب الكلاسيكيون قد قالوا بمعركة بين القديم والجديد، على مستوى المنهج، فقد قال منيف بمعركة بين القديم والجديد، على مستوى المنظور السياسي، إذ للقديم سجونه وتبعيّته وولعه بالكمّ، وإذ الجديد دعوة إلى الحرية والمساواة.
وصف منيف الرواية بأنها ذاكرة ثانية، تحتفظ في «أرشيفها» بصور البسطاء الذين هدّهم الجوع والتعب والمطاردة -كما في روايته «الأشجار واغتيال مرزوق» (1973)- وتكشف عن الأسباب الخارجية التي جعلت العالم العربي اليوم على ما هو عليه. ولهذا عاد في «مدن الملح» إلى نهايات القرن التاسع عشر، باحثاً عن الأسباب التي أنتجت سلطات سياسية تعيش في العالم المعاصر ولا تنتمي إليه. وهو ما دعاه في «أرض السواد» إلى العودة إلى تاريخ العراق في عشرينيات القرن التاسع عشر، باحثاً عن أسباب «حداثة موءودة»، حيث الحاكم الإصلاحي المستنير تخذله حاشيته المتخلّفة قبل أن تدكّه الأساطيل الأجنبية. قرأ الروائي الفرق بين «الشعب» و«السكّان»، إذ للشعب إرادة واعية تحترم القانون وتتطلع إلى سلطة مركزية، وإذ مجتمع القبائل والعشائر والطوائف يجهل معنى الوطن ويتعصّب لمصالحه الفئوية، التي تجعل «عراقياً» يذبح «عراقياً» آخر.
حوّل منيف الكتابة الروائية إلى شكل آخر من الكتابة التاريخية، منتجاً «رواية عالم ثالثية»، إن صحّ القول، توحّد بين الكتابة والسياق، وتعرف أن «قضايا الشمال» تختلف عن «قضايا الجنوب». ومهما تكن الأسئلة المتعددة التي طرحها الروائي، فقد بقيت «الديمقراطية» هاجسه المستمر. يقول: «إن الديمقراطية ليست مطلباً يسهل تحقيقه، كما أنها بذاتها ليست حلاً كاملاً، وإنما هي المناخ وبداية الوصول إلى الحلول. ومع ذلك علينا أن نعترف أن لها أعداء كثيرين في الداخل والخارج، لكن أخطر ما يواجهها أن كثيرين ممن ينادون بها غير مقتنعين بما فيه الكفاية».
دافع منيف، الذي رضي بالمنفى خياراً، عن صورة المثقف الذي يمارس ما يقول، ويدرك أن الثقافة نهج في الحياة، يجمع بين القيم والتنوير، ويستأنف جهود عقول مستنيرة سابقة. يقول منيف: «الديمقراطية ليست نموذجاً نقيس عليه، بل هي في جوهرها العميق ممارسة يومية تطال جميع مناحي الحياة، وهي أسلوب للتفكير والسلوك والتعامل، وليست مجرد مظاهر أو أشكالاً مفرغة الروح».
منيف، مثقف عاش زمانه، وترك آثاراً مضيئة تدلّ عليه، وحّدت بين الحلم الفردي والأحلام الجماعية.
| عبد الرحمن منيف: الكتابة التحريضية وسياسة الكتابة |
| 09-Apr-2009 |
| العدد 71 |