

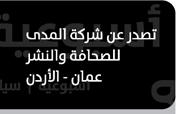
محمود الريماوي
مضى الزمن الذي كانت فيه المملكة عرضة لتحدّيات خارجية، لا سيما من محيطه المتفجّر بدءاً من منتصف القرن الماضي. تنتسب تلك التحدّيات لحقبة الحرب الكونية الباردة، ورديفتها الحرب العربية الباردة. الأردن كان طرفاً في معسكر دولي (غربي، بقيادة الولايات المتحدة)، وعضوا نشطاً في معسكر عربي يضم خصوصاً المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. فيما كانت الحياة السياسية الداخلية، تموج بتيارات قومية ويسارية رغم إعلان الأحكام العرفية وتطبيقها. ووقعت البلاد والعباد تحت وطأة نزعة رسمية استئصالية للعمل السياسي، ونزعة انقلابية لدى الأحزاب المعارضة.
في تلك الفترة، تعرض الأردن لهزات ذات مصدر خارجي أو بتفاعل مع الخارج. وبينما كان الأردن منكبّاً على طريقته على تدعيم استقراره منذ العام 1955، شهد العام 1967 احتلال الشطر الغربي من المملكة، ليتبين أن الدولة العبرية كانت في واقع الحال تشكل الخطر الفعلي والأكبر. لم تَحُل الصداقة الأردنية مع الولايات المتحدة دون وقوع هذا الاحتلال. حتى أحداث أيلول 1970، ما كان لها أن تقع لولا أن الاحتلال ألقى بثقله على الأرض والشعب غربي النهر.
بعد مضي أكثر من أربعة عقود، ما زال الأردن يعاني من آثار الاحتلال. وبعد خمسة عشر عاماً على توقيع معاهدة السلام مع تل أبيب، فإنه من الثابت أن المنظور الإسرائيلي (منظور القوى اليمينية النافذة) للسلام، ليس منظوراً سلمياً، ويتعاكس مع رؤية الأردن وحقوقه ومصالحه.
وإذ يتكرس اليمين الإسرائيلي بمكوناته المختلفة، كممثل “وطني” للجمهور العريض هناك، فإن زخم هذا اليمين يلقي بتحديات جسيمة على الأردن، منها محاولة تسويق “الخيار الأردني” في الضفة الغربية، وتحميل الأردن تبعات القضية الفلسطينية التي رفض المحتلّون أيَّ حلّ عادل لها. تقتضي هذه التحدّيات منعة الجبهة الداخلية، وتفتح مكوناتها السياسية والاجتماعية، وتنشيط علاقات الأردن العربية والخارجية، وحسن التأثير في الإدارة الديمقراطية ومراكز النفوذ في واشنطن.
لقد أمكن صيانة الاستقرار مع مرحلة التحول الديمقراطي، واضمحلت المخاوف من الداخل، غير أن المخاوف من الخارج لم تهدأ حينئذ. في العام 1990 خشي الأردن خشية بالغة من تفاعلات الاجتياح العراقي للكويت، ومن حرب “عاصفة الصحراء” التي تلتها، واهتزت علاقته للمرة الأولى بالإدارة الأميركية وبدول خليجية. يتحمل المسؤولية عن ذلك نظامٌ عربي اجتاح دولة مجاورة، وكذلك فقدان المجموعة العربية لآلية مناسبة لحل الأزمات. وقد تكررت الأزمة في العام 2003 مع الاحتلال الأميركي للعراق في ظروف أشد تعقيداً، وفي حومة الحملة على الإرهاب، وهي حملة متشعبة لم تتأخر سائر الدول العربية ودول العالم في الانضمام لها، وذلك عقب زلزال الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001. نال الأردن نصيبه من تفشي ظاهرة الإرهاب، وقد أمكنه التصدّي لهذه الآفة مستنداً لخبرات متراكمة، وجهود تنسيقية عابرة للحدود، حتى إنه يُنسب للأردن نجاحه في إحباط عمليات وتحطيم بؤر خارج حدوده. لكنه اندفع في سياق التصدّي للظاهرة، إلى حذر أمني زائد، وإلى جمود في الإصلاح السياسي.
ومن المفارقة حقاً أن ينجم هذا الجمود مرة عن ظرف سلمي، تمثل في توقيع المعاهدة الأردنية الإسرائيلية العام 1994، ومرة ثانية عن ظرف أمني تجسد في ظاهرة الإرهاب في طورها الأخير منذ العام 2004. بما يدلل على نزعة محافظة تلتمس الأعذار في سائر الظروف لكبح العملية السياسية الديمقراطية، وهو ما يجعل النسيج الداخلي الاجتماعي أقل جهوزية للتعامل مع التحدّيات الخارجية.
من هذه التحدّيات التي تطل برأسها، التأثير الإيراني في الوضع في المنطقة، وهي مسألة تشهد انقساماً حولها لدى النخب السياسية الأردنية والعربية. بين من يرى الجمهورية الإسلامية جاراً وصديقاً، ورصيداً لمصلحة العرب في المناوأة أو الموازنة على الأقل، مع الحلف الإسرائيلي الأميركي، وبين من يرى في النظام الإيراني قوة نفوذ إقليمية تبحث عن امتدادات ومصالح لها، لتحسين موقعها التفاوضي مع واشنطن والغرب، وأن هذا النظام لا يعبأ بمطلب التفاوض حول الجرز الإماراتية الثلاث التي يحتلها، ولا يكفّ ممثلون بارزون له عن إظهار مطامع تجاه البحرين، فضلاً عن مخاطر الملف النووي على دول الإقليم، بخاصة وأن طهران لا تتبنى مطلب إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، بل تتشبث بحقها في تعظيم قدراتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية.
مع بروز محور أو معسكر إقليمي تحتل فيه إيران موقع القلب والصدارة، تظل أمام الأردن فرصة التفاهم والتنسيق مع سائر الدول العربية لبناء موقف عربي متجانس، وليس سراً أن اجتماعات المصالحة الأخيرة في الرياض (الأربعاء 11/3/2009) التي تمهد للقمة العادية في الدوحة، تتناول في جانب منها بلورة موقف عربي يدعم العلاقات العربية الإيرانية، ويَحُول في الوقت نفسه دون استخدام الأراضي والمجتمعات العربية كعمق سياسي للدولة الجارة.
يلاحَظ في هذا المعرض أنه في الوقت الذي كانت فيه الأنظار، وما زالت، تتجه إلى رؤية مشروع عربي ذاتي ينهض بالحقوق والمصالح القومية، أمام اندفاعة المشروعين الأميركي الإسرائيلي، والمشروع الإيراني، فقد جاءت المساهمة من بلاد الأناضول، التي احتفظت جمهوريتها العلمانية بطابعها هذا وبعلاقاتها الأطلسية، لكنها أخذت تتصدّى “سياسياً” مع حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، للنزعة العسكرية الأميركية في الحرب على العراق، وللسلوك الإسرائيلي التوسعي والدموي، في وقت لم تتخلَّ فيه من جانبها عن رعاية مفاوضات سورية إسرائيلية مباشرة. أنقرة بذلك تنهض بمشروع، يُفترض أن يصدر عن العرب.
من مصلحة الأردن تدعيم علاقاته مع الجار “العثماني”، والتخفف من الإرث التاريخي بمناهضة الدولة العثمانية، وكذلك التحالف السابق مع الرموز التركية الموالية للغرب. وقد يكون في تعزيز العلاقات مع الدولة الإقليمية الصاعدة، فرصة لمكر التاريخ والحغرافيا معاً، وعلى نحو إيجابي، بمراجعة المعادلات الإقليمية وتوسيع الخيارات.. فتنشأ صداقة مع الغرب مع حقّ وواجب الاختلاف معه. كذلك مع تل أبيب يبقى التوجه السلمي معها، لكن مع موقف نقدي حازم وإجراءات سياسية ضد أدائها التوسعي والعدواني، وكذلك مع الجار المسلم الإيراني. ولا يعود العالم العربي مجرد مسرح لنفوذ قوى خارجية متنافسة ومتناحرة.
يعتقد سياسيون أردنيون كثر أن السياسة الأردنية ذات رصيد طيب في بناء التوازنات وتشييد الجسور مع سائر قوى عالمنا، وذلك صحيح ومشهود له، غير أن من المهم بعدئذ التماسَ مزيد من الفاعلية، حتى لا نظل في موقع المتلقي، فالمهم هو الإسهام في تغيير المعادلات ونزع المخاطر الوجودية، وسلوك طريق تؤدي إلى التحرر التدريجي من ضغط الحاجة للمساعدات الخارجية، وهو من التحدّيات البنيوية، التي لا مفر من التعامل الناجع معها بهدف الوصول إلى وضع تنتفي فيه الحاجة إليها وإلى تأثيراتها السياسية..
| مع انحسار التهديدات ورغم بروز "التحدي الإيراني" إسرائيل تحتفظ بمصدر خطر دائم على الأردن |
| 12-Mar-2009 |
| العدد 67 |