

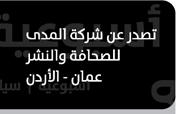
ستيفن غلين*
خاض السيناتور باراك أوباما حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2008 بسجل حسابات حافل، وكانت المدخلات السالبة والإيجابية في سجله متوازنة إلى حد كبير.
المدخلات السالبة كانت مثيرة للإحباط: رجل أسود بإرث إسلامي، صغير السن بخبرة محدودة كنائب فيدرالي. عارضَ أولئك الذين ادّعوا أنهم أحقّ منه بالحكم، بمن فيهم هيلاري كلينتون، زميلته في مجلس الشيوخ والمفترض أنها الوريث الفعلي للأسرة الحاكمة التي بدأت بزوجها وقطعَ تسلسلَها بفظاظة جورج بوش.
أما مدخلاته الإيجابية فإنها كانت موازية في أثرها الهائل. فلم يحدث منذ حملة جون إف. كينيدي الرئاسية في العام 1960 أن شاهد الناخبون مثل هذا المرشح الجذاب على مستوى العالم: فقد كان مفوهاً في مجتمع كانت فيه الخطابة قد تحولت نتاجاً إنسانياً. وسرعان ما أصبح هادئاً، وماكراً وخارق الذكاء، وكانت لباقته في التحدث إلى الجماهير في مثل لباقة رونالد ريغان، وحضوره الجذاب على المسرح يستدعي بيل كلينتون، ولكن من دون نهمه. ولكونه قادراً على معرفة الناس، فإنه أحاط نفسه برجال ونساء لا يقلّون عنه كفاءة وانضباطاً.
ثم كانت هناك البنود غير العادية في سجله، والتي كان لها الفضل في أن يشق طريقه في صورة استثنائية. فقد قام بحملته الانتخابية على أنقاض رئاسة بدأت في التخريب على نفسها فور إعادة الانتخابات في العام 2004، بخطة كارثية لخصخصة الضمان الاجتماعي. ثم تبع ذلك إعصار كاترينا، والكارثة الطائفية في العراق، واتهام مسؤول كبير في البيت الأبيض لعقده صفقة مع وكالة الاستخبارات المركزية، وكشف حالة تنصت غير مرخصة، وتسييس دائرة القضاء التي كانت يوماً ما مقدسة، وأخيراً وهو ما كان أمراً حاسماً، انهيار «وول ستريت» وبداية الركود الاقتصادي. ولدى مقارنتها بالإرث التراجيكوميدي لرئاسة بوش، فإن سلبيات أوباما تبدو بالغة الضآلة.
في مثل هذه الحالة، هل كان انتصار السيناتور الشاب حدثاً تاريخياً فائق الأهمية مثلما نُظر إليه؟ هل تحول الأميركيون حقاً عبر إنجازات أوباما ونداءاته الإنسانية، إلى التسامح والكياسة؟ أو أنهم ببساطة تمردوا على ثمانية أعوام من الحكم الجمهوري السيئ، والذي علقَ بالمتحدي الجمهوري جون ماكين مثل رائحة الموت؟
ما من شك في أن انتخاب أوباما حدث تاريخي يجب الاحتفال به. فقد كانت حملته شهادة على قوة ضبط النفس والعقل، في وقت كان فيه المواطنون – في أميركا وحول العالم – قد سئموا عجرفة النظام وغلوّه ومتاجرته بالخوف. ولا شك أن كثيرين رأوا في أوباما خلاصاً من بوش الذي فعل لتقويض المصالح الأميركية في الداخل والخارج أكثرمما فعلت أي قوة أجنبية أو خليّة إرهابية.
وفي أعقاب الانتصار الناجز للديمقراطيين أخيراً، يكون النظام السياسي الأميركي القائم على حزبَين في خطر؛ وبفضل بوش وقوميساره الشبحي، نائب الرئيس ديك تشيني، حتى لا نتحدث عن «التافهة» سارة بيلين ومجموعتها المعادية للثقافة، يكون الحزب الجمهوري – حزب لينكولن، أقدم حركة سياسية في العالم – قد انتهى إلى مجموعة مغلقة من المسنّين البيض الجنوبيين.
وكان لحملة أوباما المتألقة أن مزجت بين شبكة الإنترنت وحميمية الجماهير من أجل نتيجة حاسمة، وفيما استهلكت الإدارة نفسها بعدم كفاءتها، وفيما كان المرشحون الساعون إلى الحلول محلَّها يتهاوون واحداً بعد الآخر، كانت دعوة أوباما الخالية من الأخطاء تبدو عصية على المقاومة. وفيما كان ماكين يستسلم بسماحة ليلة الانتخابات، فإن منافسه أجرى سباقاً متفوقاً ومنحه المنتخبون التصويت المناسب. ولا شك أن مؤرخي الانتخابات الرئاسية سيدرسون حملة انتخابات أوباما مثلما يشرح العسكريون انتصار ولينغتون في «واترلو» (مقارنة غير مكتملة، في الواقع، لأن ماكين لم يكن بونابرت!).
غير أنه كان هناك بند مظلم في نصر أوباما الذي كان نصراً لقوى الاستنارة، فمحاولات أعداء أوباما للتعريف به بوصفه مسلماً، رغم أنها لم تكن من التأثير بحيث تحرف مساعيه عن مسارها، إلا أنها كانت من الجدية بحيث جعلته يتخذ موقف الدفاع. لقد كان حريصاً على ألاّ يلتقط صوراً مع مسلمين في أي مكان، ناهيك عن المساجد. وكان قَسَم الولاء الذي قدمه لإسرائيل أمام لجنة الشؤون السياسية الأميركية الإسرائيلية محاكاةً مقنعة للسياسة الأميركية التي تدور في أروقة البيت الأبيض تماماً، كما كان مقنعاً تقليد الممثلة الكوميدية تينا فاي لـ سارة بيلين؛ ولكن من دون الضحكات. فخلال جولته في الشرق الأوسط تماهى أوباما مع الإسرائيليين في «كيبوتساتهم» بحرارة، لكنه خصص نحو 45 دقيقة للفلسطينيين. وبينما كان يزور الضفة الغربية لم يقف لالتقاط أي صورة، كما أنه لم يعقد مؤتمراً صحفياً، وكان واضحاً أنه يتجنب الناس الذين يمثلون نصفَ سلام متفاوَض عليه في المنطقة الظلماء.
على الجانب الجمهوري، قالت سيدة لـ ماكين إنها لن تصوّت لـ أوباما لأنه «عربي». ردُّ ماكين كان أصيلاً وحقيقياً، إن لم يكن تعبيراً غير مقصود عن رهاب الإسلام في أميركا. ماكين قال «لا، إنه رب عائلة محترم».
صفحات الرأي في الصحف الليبرالية الأميركية عموماً –«نيويورك تايمز»، «واشنطن بوست»، و«نيوزويك»– تجاهلت إجابة ماكين، مثلما تجاهلت إهمال أوباما للجالية المسلمة في البلاد. لم يكن ليتصدى ويعترف بهذا التعصب الأعمى والعنصرية إلا كولن باول، أول وزير خارجية من أصول إفريقية في أميركا، وعلى ما يبدو رجل الدولة الوحيد فيها. ويستحق تعليقه في مقابلة مع برنامج «واجه الصحافة» على شبكة «سي.بي.إس» التلفزيونية الاقتباسَ كاملاً:
«أنا منزعج أيضاً، ليس مما قاله السيناتور ماكين، بل مما يقوله أعضاء الحزب الجمهوري، ومما يسمح بقوله، مثل هذه الأشياء: (حسناً، أنت تعلم أن السيد أوباما مسلم). حسناً، الإجابة الصحيحة هي: (إنه ليس مسلماً، إنه مسيحي، وهو كان دائما مسيحياً)، لكن الجواب الصحيح حقاً هو: (وماذا لو كان كذلك؟ هل من الخطأ أن يكون مسلماً في هذه البلاد؟)، الإجابة هي: (لا. تلك ليست أميركا). فهل هناك خطأ في أن يكون طفل في السابعة أميركياً مسلماً، يعتقد أنه من الممكن أن يكون رئيساً؟ كما أنني سمعت من أعضاء قدامى في حزبي يشيرون إلى أنه مسلم وقد يكون مرتبطاً بالإرهابيين. هذه ليست الطريقة التي يجب التعامل بها في أميركا».
في السياسة هناك دائماً خطوط حمراء. من قد يصفح عن أوباما إرضاءً لحشد كبير من الناخبين المناوئين للإسلام، في حين أنه كان يقوم بدور السمسار لوكلائهم الليكوديين، مفترضاً أنه سوف يحتسي كأساً مع الشيطان اليوم بدلاً عن عقد سلام دائم في الشرق الأوسط غداً. لكن ذلك يقول شيئاً عن فضيلة مجتمع، حيث يتطلب بذلُ أي محاولة جدّية لإزالة المعاناة عن شعب مضطهَد، القيامَ بما فعله أسلاف أوباما، لكن من الباب الخلفي.
لقد كانت نتيجة الحملة الرئاسية الأميركية لانتخابات 2008 بمثابة تحية مطلوبة وملطفة بعد قرنين من التمييز العنيف ضد الأميركيين الأفارقة. ومع كل ما فيها من خلاص، فإنها سنّت حقيقة جديدة في مجال السياسة الإثنية والدين: المسلمون الأميركيون، وبخاصة العرب، هم الزنوج الجدد.
محرر في "نيوزويك" الدولية
| نجح أميركي من أصل إفريقي والعرب هم الزنوجُ الجدد |
| 13-Nov-2008 |
| العدد 51 |