

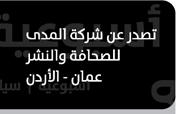
صلاح حزين
في حياة لا مكان فيها لوسائل الترفيه؛ لا تلفزيون أو فيديو ولا كومبيوتر، ولا حتى راديو، فقد كانت ملكية الراديو ترفا بالنسبة لكثير من المقيمين في الشطر الشرقي من عمان، مثلي، كان لعب كرة القدم في المساحات العديدة المتوافرة في أطراف أحياء عمان الشرقية تحت الشمس اللاهبة، من بين الوسائل القليلة التي يقضي فيها أطفال عمان يوما قائظا في رمضان، فما زلت أذكر أن رمضان في أواسط الخمسينيات كان في فصل الصيف. لعب وركض وتعب وجفاف حلق، كانت مواصلة الصيام بعدها تعد نوعا من جهاد النفس وعنوانا لأجر عظيم سوف يجزينا عن تعبنا وجوعنا، وبخاصة ظمأنا.
الذهاب إلى "الجامع"، كان خيارا آخر يلجأ إليه سكان عمان آنذاك؛ رجالا وشبانا وأطفالا، لقضاء يوم من أيام رمضان. "الجامع"، كانت كلمة تعني أساسا، الجامع الحسيني، فلم يكن هناك الكثير من المساجد في عمان الخمسينيات. كان "الجامع" بجنباته الرحبة وساحته المكشوفة المحيطة بالموضأة، ملاذا للمتعبدين، وللصائمين الذين كانوا يقضون فيه شطرا من يومهم الطويل، ومنهم الأطفال الذين كانوا يرومون الحصول على أمرين في الوقت نفسه: أجر عن الفرض الذي يؤدونه رغم سنهم الصغيرة، و"تسلية" صيامهم بما ينفعهم في الآخرة، مثلما ينفعهم في الدنيا.
كانت جنبات المسجد تمتلئ بالزوايا التي اتخذها بعض المجتهدين أمكنة لإلقاء مواعظ دينية للحضور الذين كانوا يتوزعون على الوعاظ الموزعين بدورهم على مساحة المسجد الواسعة؛ قرب المحراب، أو في الساحة الخارجية المكشوفة، فيما كان آخرون يلتفون حول ضرير يقرأ بعض القصص القرآني بطريقة بريل؛ كانت أعيننا الدهشة تتتبع يدي الطفل الضرير (كان هؤلاء في معظمهم أطفالا)، وهي تلمس الأحرف البارزة التي تتحول لديه حروفا منطوقة وكلمات تشكل في النهاية قصة وعظية أخلاقية، أو حكاية حول أحد الأنبياء. بالنسبة لنا، نحن أطفال ذلك الزمان، كان المشهد بأكمله ضربا من المعجزات الرمضانية.
آخرون كانوا يلتفون حول مقرئين يتلون آيات من القرآن بأصوات تتفاوت في جمالها وقوتها وتفننها في التجويد، الذي كان ينتزع في نهاية كل آية كلمات الاستحسان التي كانت تتفاوت، هي أيضا، في القوة والارتفاع والانخفاض، تبعا لدرجة تأثر المقرئ بالكلام القرآني. آنذاك لم يكن الترتيل، الذي أصبح سائدا الآن، معروفا بعد. وكان التجويد، الذي يعده البعض في يومنا هذا نوعا من تلحين القرآن، لأنه يعتمد المقامات نفسها المستخدمة في الغناء، هو السائد، وكان المثال الأسطع على عظمة هذا النوع من القراءة في تلك الفترة، الشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد، الذي كانت له شهرة توازي شهرة مطرب شباب ذلك الجيل، عبد الحليم حافظ.
كنت آنذاك معجبا بمقرئ ذي صوت جميل كان يتخذ زاوية محددة قريبة من محراب المسجد مكانا دائما له، وكان إعجابي بصوته يتحول إلى نوع من النشوة عندما كان ينتقل في قراءته من الصوت المرتفع، المسمى القرار، إلى الصوت الخفيض، جواب القرار، حيث كان يتنقل من آية إلى أخرى، معتمدا على نفسه الطويل الذي كان يستخدمه في تمديد القراءة حتى النفس الأخير، ما يوصل الحضور المتفاعل معه إلى الإمعان في التهليل وبإسباغ معاني الإعجاب والتقدير، وكنت معهم. كان ذلك المقرئ هو محمد أبو شوشة، الذي كان أكثر المقرئين شعبية في المسجد الحسيني في تلك الأيام من خمسينيات القرن الماضي. وقد عرفت أنه ما زال على قيد الحياة ولكنه يعاني أمراض الشيخوخة.
وأذكر أنه حدث أن انقطع عن المجيء إلى المسجد فترة من الزمن، وبعد أشهر شاهدته يسير في سوق اليمانية، سوق البالة في وسط البلد الآن، وكان يحمل في يده عودا. وحين استفسرت من بعض زملائي عنه قالوا لي إنه تحول إلى الغناء. ولكن شقيقه، الذي كان مؤذنا في المسجد، استمر في أداء الآذان. وبعد فترة طويلة سمعت أن محمد أبو شوشة ترك الغناء وتحول إلى منشد يقود فرقة تؤدي الأناشيد الدينية.
على يد محمد أبو شوشة تخرج عدد من المقرئين الذين تتلمذوا على يديه.
واليوم، من يذهب لأداء صلاة الجمعة في مسجد أبو درويش في جبل الأشرفية، فإنه سيستمع إلى المقرئ الشيخ إبراهيم الصالحي، الذي كان معروفا بصوته الجميل بين طلبة مدرسة الأحنف بن قيس في جبل الجوفة، وخاصة حين كان يؤدي أغنية محمد عبد الوهاب التي كانت حديثة آنذاك، النهر الخالد. إبراهيم الصالحي الآن هو إمام مسجد دروزة، وهو يقرأ القرآن كل يوم جمعة في جامع أبو درويش في جبل الأشرفية، ومرة كل شهر في المسجد الحسيني، كما يقرأ في مناسبات أخرى في مسجد الملك عبد الله. عاصر إبراهيم الصالحي محمد أبو شوشة، إذ كان طالبا في مدرسة كان يدرس فيها أبو شوشة، فقد كان التعليم مهنته أساسا، وكان إبراهيم من المعجبين بصوت أستاذه، ولكنه طور لنفسه على مر السنين أسلوبا خاصا يستخدمه الآن في قراءته.
المدرسة المصرية في تجويد القرآن هي التي كانت سائدة آنذاك، فلم يكن الترتيل المنتشر في صورة طاغية الآن معروفا. وكان انتشار التجويد ثمرة للتأثير الواسع للإعلام المصري آنذاك، وكذلك للدور الذي كانت تلعبه مصر، بلد الأزهر، في إرسال مجموعات من الواعظين والمقرئين إلى بلدان بعيدة في آسيا وإفريقيا، وفي بلدان عربية عديدة من بينها الأردن. كان المقرئون يأتون أساسا إلى عمان والقدس التي كانت العاصمة الروحية للبلاد آنذاك. وفي إطار هذه الأنشطة أتيح لي أن أستمع إلى مقرئ كان شهيراً في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، هو أبو العينين شعيشع، الذي كان يتمتع بصوت يجمع الجمال إلى القوة وطول النفس. وقد لقي أبو شعيشع في عمان استقبالا يليق باسمه الشهير آنذاك، ومع انتهائه من تلاوة كل آية من الآيات كانت الأصوات ترتفع بالتهليل: "ألله" ممدودة على آخرها، "ألله ينور عليك"، ولم يكن يندر أن ينتظر أحد المستمعين انتهاء موجة التهليل وسيادة السكون حتى يهتف ببضع كلمات تعبر عن إعجابه بالمقرئ، فهو متأكد الآن أن صوته لن يضيع بين ذلك الحشد من أصوات المهللين، وأن الساحة خالية له الآن ليعلن إعجابه بصوت مفرد، تماما مثل صوت المقرئ الذي ما يلبث أن يستأنف قراءته الشجية.
لكن الاستقبال الأكبر كان ذاك الذي حظي به عبد الباسط عبد الصمد، الذي حضر إلى عمان والقدس، وأحيا بصوته العذب الجميل أكثر من أمسية قرآنية. قرأ عبد الباسط القرآن في المسجد الحسيني في عمان. وقد شاهدت كيف كان المواطنون الذين فاض بهم المسجد، فملأوا ساحة المسجد الحسيني حتى بدايات شارع بسمان، يقفون تحت المطر الغزير مستمعين إلى المقرئ الشهير بصوته الذي نقلته مكبرات الصوت عبر أرجاء عمان كلها، كان ذلك في شهر شباط/فبراير 1967 الذي كان ماطرا في صورة خاصة. بعد ذلك بأيام غادر عبد الباسط عبد الصمد إلى القدس ليحيي أماسي قرآنية استمرت طوال شهر رمضان. وكان ذلك آخر رمضان تشهده القدس قبل احتلالها في الخامس من حزيران من ذلك العام.
| رمضان في عمان الخمسينيات: حين كان المسجد الحسيني ملاذاً للصائمين والوعاظ والمقرئين |
| 04-Sep-2008 |
| العدد 42 |