

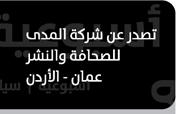
جعفر العقيلي
كان سيختار طريقة أخرى يموت فيها بالتأكيد، لو قُيِّض له ذلك. ميتة أكثر درامية من تلك التي رحل فيها يوسف شاهين، تليق بمنجَز يمكث في الأرض بعده، ويختتم بها حياةً استحالت على يديه دراما بثّ فيها موقفه بشجاعة الفارس النبيل، منافحاً عمّا تبقى من قيم إنسانية بدأت تخبو في زمنه، وعلى رأسها الحرية.
أحدسُ أنه كان يفضّل –لو سُئل- أن تكون إغماضته الأخيرة في الإسكندرية، مدينته التي أحبَّ فخلَّد، لا في القاهرة التي عاد إليها بعد نزف في الدماغ اضطره للسفر إلى باريس، تاركاً تساؤله "هيّ فوضى!" برسم الإجابة، في فيلم حملَ توقيعه رغم ما قيل من أن مساعده خالد يوسف هو الذي أنجزه، بعد أن فعلت الشيخوخة فعلها فيه، دون أن يأبه بها، فما يزال لديه الكثير ليقوله. ولكن..
هو واحد من أولئك الذين استهوتهم لعبة "الحياة"، ولكن على طريقته، فناضل مخترقاً الحواجز ليفرّغ طاقته الإبداعية في أفلام ناهزت الأربعين توزعت على 57 سنة، صنع فيها "النجومَ"، ومرّر الرسائل، واكتوى بنار قُصور الفهم في تناولها، دون أن يتراجع قيد أنملة. كيف لا، وهو الذي أثار سخط محافظين ومتشددين بقائمة طويلة من الأفلام ما انفكت تستعين بالتاريخ وتستحضر العلاقة مع الآخر على إطلاقه، خصوصاً في لحظتها الملتبسة.
هكذا كان يوسف، أو "جو" كما يدعوه أصدقاؤه، صانعَ أفلام إشكالياً، "زوربا" بهيئة مختلفة، باحثاً عن خلاص بمعنى ما، فما تردَّدَ في "نشر غسيل" العائلة وهو يبوح سينمائياً بتفاصيل سيرة ذاتية أشّرت على جرأة تحلّى بها وحده، ودفعت كثيرين إلى اتهامه بـ"جنون العظمة"، دون أن يفطنوا إلى أنه كان يسرد في ثلاثيته ("الاسكندرية ليه" 1978، "حدوتة مصرية" 1982، "اسكندرية كمان وكمان" 1999) حكاية شعب انتمى إليه انتماءَه لذاته، وحكاية أمة أضاعت البوصلة، فكان من أمرها ما كان.
بدأ شاهين المولود بالاسكندرية (1926) مسيرته في عالم السينما بفيلم "بابا أمين" (1950)، مختطّاً له درباً أراد فيه أن يكون نسيجَ وحده بعد عودته من أميركا التي ذهب إليها وفي باله أنها "مصنع الأحلام" الأكبر في العالم، عبر ما تنتجه هوليوود. وبدأت ملامح خصوصيته تتشكل في فيلمه "ابن النيل" الذي صور فيه آخر فيضانات النيل في العهد الملكي، وعلاقة الفلاح ببيئته ومعركته مع البرجوازية. ثم جاء "صراع في الوادي" (1954) صرخةَ احتجاج في مواجهة الإقطاع ورموزه.
هكذا توالت أفلامه: "صراع في الميناء" (1956) منحازاً إلى العمال وقضاياهم. أما المحطةُ التي يراها نقاد منعطفاً تاريخياً فهي تجربته: "باب الحديد" (1958) الذي شارك شاهين فيه ممثلاً أيضاً، وحاز جائزة أحسن ممثل على دوره من مهرجان برلين السينمائي. واستجابةً للمد القومي الذي بلغ أوجَه حينئذ، كانت الجماهير على وعد مع "جميلة"، الفيلم الذي استعرض حكاية المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، ببلاغة مؤثرة بعثت الحماسة في الذين شاهدوا الفيلم ليقوموا بأعمال شغب ضد السفارة الفرنسية. استدعى شاهين بعد ذلك "الناصر صلاح الدين" في فيلم أراد منه أن يكون تحية لعبد الناصر الذي بدا للحظةٍ في مواجهة العالم، وعُدَّ الفيلم أحد أشهر كلاسيكيات السينما العربية. وفي موقف رافضٍ لعدد من ممارسات "الثورة" في التعاطي مع الشأن الفني حمل شاهين أمتعته إلى لبنان، لينجز فيلماً ما يزال له حضوره المتجدد في مشهد مزدحم. ذاك هو فيلم "بياع الخواتم" الذي أدت فيه فيروز دور البطولة. ولم تكن تلك تجربته الأولى التي يسند فيها دور البطولة لِمُغَنٍّ، إذ أخرج لفريد الأطرش "ودّعت حبك" و"إنت حبيبي" اللذين ضمّا باقةً من أشهر أغنيات فريد. وبعد عقود، في مطلع الألفية الثالثة، أخرج "سكوت حَ نصوّر" من بطولة لطيفة التونسية، الذي دافع فيه عن الطرب الأصيل ودان الأغنية الشبابية "الهابطة" بشدّة.
لم يكن البيان الرئاسي الفرنسي في نعيه مفاجئاً، إذ هو تعبيرٌ عن عمق العلاقة وتجذّرها بين شاهين وفرنسا، بوصفها "آخَرَ" حملَ بموازاة ميوله الاستعمارية لمصر، نهضةً لم تكن تحلم بها في القرن الثامن عشر، وهو ما كان تناوله فيلم "وداعاً بونابرت" (1985). ثيمة "العلاقة مع الآخر" واصلت "توريطَ" شاهين بها، فأخرج فيلمه الشهير "الآخَرَ" الذي وُوجه بحملة شديدة كان أطلقها ضده متشددون مدفوعين بما كانوا شاهدوه سابقاً في "المهاجر" (1994) من تعالقٍ بين شخصية النبي يوسف والشخصية الرئيسة في الفيلم. وكان "المصير" (1997) فيلماً يستحضر التاريخ أيضاً، عبر حكاية المتنوّر ابن رشد الذي حاصرته قوى الظلام. وفي أفلامه هذه، كما بقية أفلامه، تتواصل الإسقاطات على واقع نحياه، لتبدو شخصيات أفلامه وكأنما تتسلل بيننا وتعيش بين ظهرانينا، بوصفها من لحم ودم.
تتوالى إبداعات شاهين في الفن السابع بما لا يمكن معه حصرها في مقالة تودّعه بالأسى محتفيةً بما قدمه باندفاعةٍ وحماسةٍ لم تتأتَّ لغيره. ثمة في السياق فيلم "العصفور" (1973) الذي أقام مقارنةً نتائجها محسومة مسبقاً بين شعب يملك إرادة الانتصار ودولة تئن من وطء الهزيمة. وقبله، كان شاهين ارتقى برواية عبد الرحمن الشرقاوي "الأرض" المتواضعة فنياً، محولاً إياها إلى فيلم ملحمي يعده بعض النقاد أفضل أفلامه.
لا يكفي أن يُذكَر شاهين في باب "الريادة التاريخية" وحسْب، فهذا باب يبعث على اللبس، ويتساوى فيه القمح مع الزوان. كان شاهين حالةً متفردة في المشهد السينمائي العالمي، وقامة رفيعة يتفق عليها محبّوه ومنتقدوه على السواء، رغم اختلاف الأخيرين مع ثيمات أو تفصيلات على هامش درب إبداعي طويل حلّق في أجوائه "العصفور" قبل أن يغادر مطمئناً إلى أنه روى "حدوتة مصرية" على أكمل وجه. يوسف شاهين: وداعاً.
| رحيل “حدوتة مصرية” |
| 31-Jul-2008 |
| العدد 37 |