

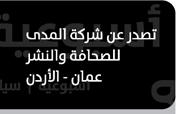
صلاح حزين
في اللقاء الأخير الذي جمعني بالمفكر الراحل عبد الوهاب المسيري، سألته عن السبب الذي يجعل ما يقوله مقبولا لدى جماهير عريضة من الناس، ربما يشكل الإسلاميون غالبيتهم، علما بأنه قد يكون مخالفا، وربما مناقضا لما يعتقدونه. أجابني يومها بأن السبب يعود إلى أنه لا يملك أجندة خاصة به، وأنه غير محسوب على تيار بعينه، وأن ما يقوله يستند إلى إيمان راسخ وعلى بحث وثقافة مؤصلة تبتعد عن الخفة، ما يجعلها مقبولة. وختم حديثه بالقول: والله أعلم.
كان المسيري قبل ذلك بيوم قد ألقى محاضرة في مقر منتدى الفكر العربي في زيارته الأخيرة إلى عمان، وكانت المحاضرة تدور حول "زوال إسرائيل"، وهي فكرة شغلته طويلا واستعد لها متسلحا بأمثلة وشواهد اجتماعية وسياسية راهنة، وأمثلة تاريخية ماضية. وكان قد استهل محاضرته التي قدمها في ذكرى النكبة في شهر أيار/مايو الماضي، وهو الوجه الآخر لذكرى تأسيس إسرائيل، بالطلب من الجمهور بألا يسأله عن علاقة إسرائيل بالتلمود والتوراة وبروتوكولات حكماء صهيون، لأنه لا يؤمن بوجود علاقة بين كل ذلك وبين إسرائيل التي هي نتاج مشروع استعماري أوروبي أساسا، كما يرى، وأن اليهود كانوا أداة لتنفيذ هذا المشروع الاستيطاني، وأن كثيرا من الغالبية العظمى من اليهود كانوا يعارضون مشروع الدولة اليهودية في فلسطين، لأنه يقطع الطريق على عمليات اندماجهم في مجتمعاتهم بوصفه الحل الأفضل للمسألة اليهودية.
ما أود أن أقوله هو أن الراحل المسيري كثيرا ما فهم خطأ، وأن أفكاره النابعة من تبصر عميق والمستندة إلى ثقافة رفيعة بقدر ما هي غنية ومنوعة، كثيرا ما ابتسرت وسطحت من قبل كثيرين لم يقرأوه كما أحب هو أن يقرأ، حتى لو كانت تلك القراءة تحمل اختلافا معه في الرؤية والتفسير والنتيجة أيضا. أقول ذلك من واقع خبرة شخصية معه، فأنا أزعم أنني كنت واحدا من أصدقائه الذين كانوا يختلفون معه في كثير من التفاصيل، مع الاتفاق معه على تفاصيل كثيرة غيرها.
عرفت المسيري في الكويت قبل أكثر من عشيرين عاما، في أحد المؤتمرات حول القضية الفلسطينية، وكنت قد تناولت في ورقتي التي قدمتها آنذاك "الصهيونية الثقافية"، وتناول هو إسرائيل بوصفها "مشروعا استيطانيا إحلاليا"، بكلماته. وتوثقت العلاقة بيننا بعد انتقاله عام 1988 إلى الكويت مدرسا في جامتها.
في تلك الأعوام بدأ المسيري رحلة التحول إلى الفكر الديني الإسلامي. وهي واحدة من رحلات عديدة شهدتها حياة المسيري الفكرية والثقافية والأدبية، ولكن جوهر فكر المسيري بقي واحدا فيما أرى، وهذا ما جعل المسيري يحتفظ بعلاقاته مع كثير ممن اختلفوا معه فكريا أو اختلف معهم، فقد كان على درجة كبيرة من الاستعداد لقبول الاختلاف. وفي شهر شباط/فبراير من العام 2007، عقدت في القاهرة ندوتان فكريتان، كانت الأولى حول فكرة "التحيز" وهو اصطلاح سكه المسيري، والثانية حول مسيرته الفكرية والثقافية، وخلالها قدم عدد من الأوراق التي أفصحت عن اختلاف معه، وهو اختلاف شمل مستويات عدة، وحقولا كثيرا من حقول الإبداع التي طرقها المسيري، ومنها ورقتي التي تناولت الجانب الأدبي في حياته، وطوال جلسات المؤتمر التي استمرت يومين كان المسيري هناك يستمع بهدوء إلى الأوراق، مع تركيز واضح على تلك التي حملت وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظره، ولم يعلق إلا في حدود التوضيح لفكرة له قد تكون فهمت خطأ.
رحلة المسيري من المادية إلى الإيمان، كما كان يحب أن يقول، لم تكن سوى واحدة من رحلاته العديدة كما ذكرت، فهو لم يكن مثقفا سكونيا بل كان دائم الترحال والتنقل والتحولات. وهي رحلات بدأت انتقاله من دراسة الأدب الإنجليزي متخصصا في الشعر الرومانتيكي، إلى دراسة الحركة الصهيونية في ستينيات القرن الماضي، ومن نقد الفكر الأنغلو ساكسوني إلى نقض الحضارة الأوروبية عموما، وفي ذلك فإنه يختلف عن إدوارد سعيد الذي كان ابنا للحضارة الغربية، ناقدا لممارساتها السلبية من داخلها.
ومن الواضح أن هذه التحولات أرقت المسيري نفسه، ففي كتابه "من عالم الأدب إلى عالم الفكر وبالعكس" الصادر عام 2006، يتساءل المسيري: "كيف تأتى لمتخصص مثلي في الأدب والشعر الرومانتيكي الإنجليزي والأميركي أن ينتقل من تخصصه الأكاديمي إلى تخصص آخر تماما، أي اليهودية والصهيونية".
والمسيري بتعرضه لهذه القضية "المؤرقة" إنما كان يجيب على أول سؤال قد يخطر لكل من يعرفه ويعرف أنه درس الأدب الإنجليزي والأميركي الحديث، وتخصص في الشعر الرومانتيكي في إنجلترا وأميركا من خلال رمزين أدبيين كبيرين هما الشاعر الإنجليزي ويليام وردزورث والشاعر الأميركي وولت ويتمان، وأنه تخصص فيما بعد في "اليهود واليهودية والصهيونية" وهو تخصص كتب فيه أضعاف ما كتب في الأدب الإنجليزي، وبلغ ذروته في وضعه موسوعة في الموضوع حملت اسم (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة 1999).
في أثناء دراسته للشعر الرومانتيكي الإنجليزي والأميركي في الولايات المتحدة (1960)، لاحظ المسيري أن الرومانسية تحاول تأسيس علاقة مباشرة بين الإنسان والطبيعة من دون تدخل أو وساطة وخارج إطار المجتمع الإنساني والتاريخي، ليستنتج بالتالي أن «جوهر الوجدان الرومانسي هو شكل من أشكال المباشرة الوثنية. وعبر هذا الاستنتاج اكتشف المسيري أرضية مشتركة بين الرومانسية بما فيها من «وثنية» مفترضة، وبين الفكرة الصهيونية التي تذهب إلى أن «علاقة اليهودي بصهيون لا بد وأن تكون علاقة مباشرة ولا توجد مسافة فيها بين الذات والموضوع،» ما يجعل صهيون كائنا خارج حدود الزمان والمكان.
من هذه النقطة تحديدا، بدأ المسيري تحولاته من نقد الرومانسية التي تخصص فيها كمدرسة أدبية إلى نقض الفكر الغربي بتياراته ومدارسه وتجلياته المختلفة من حداثية وما بعد حداثية ومن بنيوية وتفكيكية ونسوية، وغير ذلك من مدارس ونظريات وتيارات فكرية وأدبية يجمع بينها أنها ترى في الإنسان مركزا للكون ومرجعية للنشاط البشري لا مرجعية بعده، وهذا في رأي المسيري نوع من الوثنية. ومن هذه النقطة ينطلق إلى أخرى أبعد حين يعتبر العلمانية وهي مفهوم مرادف للدنيوية، تعني في جوهرها «نزع القداسة عن العالم»، مميزا في الوقت نفسه بين هذا النوع من العلمانية التي يسميها العلمانية الشاملة، وبين نوع آخر من العلمانية يقوم على فصل الدين عن الدولة يسميه العلمانية الجزئية.
وبعكس النقطة التي انطلق منها في نقده للرومانسية، وهو نقد إيماني، إن جاز التعبير، جاء نقده للصهيونية على خلفية مادية تماما، ففكرة أن صهيون «كائن خارج حدود الزمان والمكان»، مسألة يمكن للفكر الديني أن يقبلها، وذلك بعكس الفكر المادي الذي يرى أن من المستحيل قبول أي شيء خارج حدود الزمان والمكان، وعليه فإن جهد المسيري الأساسي في مجال دراسته للصهيونية ونقده لها، إنما يتم من خلال إنزالها من عالمها المطلق «خارج حدود الزمان والمكان» إلى عالم الواقع ودرسها في إطارها التاريخي وظرفها الموضوعي، ومن هنا يأتي اختلاف المسيري سواء في نقده أو في تقييمه أو تفسيره بعض الظواهر المرتبطة بالصهيونية بوصفها حركة سياسية أو فكرة ذات بعد ديني عن الناقدين لها انطلاقا من منظور ديني.
وزاد المسيري من هوة الاختلاف عن الإسلاميين في هذا المجال تحديدا، عبر رفضه مفاهيم أو مصطلحات مثل «اليهود» و»اليهودي»، وذلك انطلاقا من أنها مصطلحات تتسم بالتعميم الشديد، وبأن مقدرتها التفسيرية ضعيفة إن لم تكن منعدمة. ويستخدم بدلا من ذلك تعبير «الجماعات اليهودية». كما يرفض تعبير «التاريخ اليهودي»، فضلا عن تعابير أخرى مثل «الهوية اليهودية» و»الشخصية اليهودية»، انطلاقا من أنها تعابير مضللة لا تعني شيئا إن لم تنسب إلى بلد معين أو ظرف معين أو تاريخ معين، أي أنه وضعها في سياقات معينة، وهي سياقات لا يوليها المفكرون من ذوي المنطلقات الإيمانية مسيحية كانت أو إسلامية كبير اهتمام.
وأود أن أذكر هنا أن اعتراض المسيري على "وثنية" أو "لادينية" الرومانسية جاء في وقت مبكر نسبيا لم يكن فيه المسيري بعد قد أصبح "مفكرا إسلاميا"، ومن الواضح أن هذه كانت بداية الطريق في ذلك الاتجاه، ولكن تلك قضية أخرى، فما يهم هنا هو ملاحظة ذلك النزوع المبكر لدى المسيري إلى دراسة الأدب في إطار يتجاوز "أدبية النص" الأدبي ووضعه في نقطة يلتقي فيها الأدب والفكر، وهي نقطة تقع في حقل آخر غيرهما وإن كان يمت إليهما بصلة هو حقل الأيديولوجيا، ومن هنا كان جهد المسيري الأكبر في دراسة العلاقة بين الأدب المسمى "صهيونيا" وبين الفكرة الصهيونية قد تحقق في صورة عظيمة الدلالة في دراساته العديدة للجوانب المختلفة للأيديولوجيا الصهيونية ليس اعتمادا على الأدبيات الصهيونية فقط بل وعلى نصوص من "الأدب الصهيوني" بتعبير أديب فلسطين الشهيد غسان كنفاني، وأعني به هنا ذلك الأدب الذي كتب في تلك العلاقة المعقدة بين اليهودي وبين صهيون وهي فكرة تناولها كتاب وروائيون وشعراء ومسرحيون يهود أو غير يهود يجمع بينهم أنهم ينتمون إلى الغرب، فمن نافل القول إن المسيري ينطلق في النظر إلى الصهيونية من أنها نتاج للفكر الغربي الإمبريالي، مثلها في ذلك مثل النازية والفاشية.
في آخر لقاء لي به، كان المسيري على درجة كبيرة من التألق، قال لي إنه يؤلف كتابا عن "النكتة"، وبالمناسبة، روى عددا كبيرا من النكات التي كان قد قسمها إلى فئات. وودعته وهو على هذه الحالة الرائقة.ولم يكن هنالك ما يوحي بأن المفكر دائم الارتحال يستعد للرحيل الأخير.
| عبد الوهاب المسيري: الرحيل الأخير |
| 10-Jul-2008 |
| العدد 34 |