

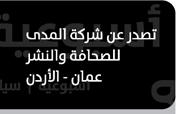
جهاد هديب
وصفه غسان كنفاني في الغلاف الأخير لإحدى رواياته بأنه «خرقة الهزيمة التي تلوح في وجه الأمة العربية». أما محمود درويش فوصفه بأنه «ينجب زعترا ومقاتلين». إنه المخيم، ذلك الشاهد والأثر الباقي الأكثر وضوحاً من هزيمة العام 1948 في ذكراها الستين.
لقد وفرت الفضائيات مادة أرشيفية سمعية، وبصرية قدمت صورة للمخيم، وتحديداً مخيمات غزة المقاتلة والرافضة لهدر حق العودة إلى المواقع التي هجِّرت منها قسراً قبل ستة عقود.
وتبرز صورة مخيم جنين، فقبل مجزرة ربيع العام 2002 كان قادة المخيم عبر الهاتف يتحدثون للفضائيات العربية قبيل استشهادهم. إنها صورة استثنائية رآها العرب كلها ورآها أهل المخيمات الأخرى. غير أن الكلام هنا سيختلف.
تلك الصور في أشكالها كافة أربكت الفن الذي يتصل بالسينما اتصالاً وثيقاً، لجهة الحاجة إلى بنية درامية متماسكة، فقد كادت الميديا تطيح بالشريط التسجيلي والوثائقي وكادت تُفقدهما دورهما، لولا أن استطاعا الارتقاء إلى مستوى أرقى على صعيد الشكل والأسلوب.
في عودة إلى المخيم ومعناه، فإن ثلاثة شرائط تسجيلية رصدت التحولات في المخيم وأجياله.
الضحية تلوذ بالأمل لا بالصمت
مسافة واسعة تفصل بين الفيلمين التسجيليين «تحدي» الذي أنتج العام 2000 والأخير «اجتياح» للمخرج نزار حسن، الذي انتقل من السخرية من الواقع الاحتلالي، الى المواجهة بالأدوات الممكنة.. أدوات المخيلة والموقف المقاوم وخوض الصراع مع احتلال همجي بالسعي الى إحراجه أخلاقياً.
وقد استطاع المخرج تطوير الرؤية تجاه ما الذي يريده من الفيلم التسجيلي باعتبار الكاميرا أداة في الصراع لا الاكتفاء بنقل الواقع مثلما هو عليه.
على هذا النحو اختار أن يبدأ شريطه من لحظة احتدام عالية، من موقع يجمعه إلى جندي إسرائيلي شارك في اجتياح مخيم جنين، شارك في ارتكاب المجزرة التي جرت ضمن ما اسماه مجرم الحرب شارون «عملية السور الواقي»، فيما هما المخرج والجندي يستعرضان شريطاً التقطه المخرج في مخيم جنين، بصحبة أحد المصورين ولم يكن جيش الاحتلال استكمل انسحابه من المخيم بعد.
ما بين الشهادة الحية التي التقطها نزار حسن من الناس فيما الآليات الفلسطينية تعمل على إزالة الأنقاض، وشهادة الجندي الإسرائيلي الذي يهدم ثم يضغط ما يهدم ويكدسه فيصلح طريقا لعبور المجنزرات، قدم شريط «اجتياح» نوعا من المفارقة بين التقنية المغلفة بالعمى الأيديولوجي في صيغته العنصرية، والغضب الذي انتاب ساكني المخيم من لاجئي 1948.
مع ذلك وبذكاء وحساسية، لم يحو الشريط الذي استغرق إنجازه عشرة شهور أياً من المشاهد المروعة، التي بثتها فضائيات عربية وأجنبية كانتشال الجثث من الردم الذي خلفته عملية «السور الواقي» والهلع الذي انتاب سكان المخيم بعد 15 يوماً من المقاومة بأسلحة تعود الى الحرب العالمية الثانية،بحسب شهادة أحد المقاومين الشبان في الشريط.
غير أن نزار حسن في تصوير مشاهد وتفاصيل «طازجة» للخراب، اختار منها ما هو محرج أخلاقياً للقاتل، كمادة شريط مدته قرابة ستين دقيقة.
في إدارته اللعبة بين الجندي والناس في مخيمهم وقد برز فيهم الغضب، لتقوض احلامهم كعائلة انفرط عقدها كزواج لن يتم، وأخرى لن يلتئم شملها ثانية وشاب لن يتمكن من العمل إلى الأبد.. هكذا يسهل على المتفرج أن يلحظ الفارق بين برودة التقنية المغلفة بأيديولوجيا عنصرية،وتدفق الغضب المتمسك بآخر خيط من الأمل.
عمد المخرج نزار حسن الى تجزئة شريطه الى عدد من اللوحات تتضمن شهادات للناجين من المجزرة، وللجندي القاتل،فيما يستعرض المقاوم الشاب مراحل المقاومة الشعبية في المخيم بين الخرائب.. ومع تقدم الشريط في عرض التفاصيل يتحول طفل متجول وحاف في المخيم الى شخصية بارزة في الفيلم. لا يقول شيئاً بل يتم من خلاله استعراض مشاهد خراب سريالية وأخرى تنتمي الى الواقعية القذرة، في المطارح التي لم يطلها هدم البلدوزرات الإسرائيلية بما يشير الى قدرات المخرج في إنجاز شريط روائي.
الطفل وهو صورة مجسدة لحنظلة قاد صاحبه نزار حسن الى بيوت كتب جنود الاحتلال على حيطانها كلمات بذيئة، وأخرى تركوا فيها غائطا وعلب سجائر فارغة، ثم خربشوا شعاراتهم بالعبرية: شكراً على الضيافة الحارة والى اللقاء في محادثات السلام.
ذلك لم يحرج الجندي الإسرائيلي قائد البلدوزر: «كان ما يهمني هو العودة الى البيت سالما، إرتكبت فظائع لم أتسبب بها». وفي نهاية الشريط وعلى شاطئ حيفا الذي هُجِّر منه اغلب ساكني مخيم جنين، وفيما يرتدي ملابس أنيقة على الطريقة الأميركية قال: كل هذه كانت عبارة عن حكاية غير لطيفة. روائح غائط (الجنود الإسرائيليين) تختلط بروائح جثث. أنتم لستم أقل منا والتعايش ممكن ( !!).
طفولة يتأرجح جسدها بين مخيمين ولا تصل
يدخل المرء الى الشريط التسجيلي: «أحلام المنفى» للمخرجة مي المصري شخصاً يمتلك قدْراً من فكرته عن نفسه.. بعد ست وخمسين دقيقة يخرج وقد خسر الشخص فكرته عن نفسه أو أنها ارتجت وذهبت من الصلابة الى حال من السيولة أو الميوعة.
دائماً هو المخيم : الظلال الكثيفة في الزقاق المعتمة، والمياه الآسنة، والعيون التي قلما تلمع، والضحكة التي تنسرق، والخفقة التي لا تكتمل، والرعشة التي تحدث في الظلام والبرد والجوع ثم تموت..
وفي سيرة الألم يبرز المخيمان بوصفهما مطرحاً تمركز فيه الألم: سجنان شاسعان، وأناس عاديون يودون لو يمتلكون رغبتهم في العيش، لذلك حدث ما حدث في شاتيلا عبر سلسلة من الكوارث بدأت مع تل الزعتر منذ العام (1978) ولم تتوقف بعد وتخرج منها تلك الرائحة التي تنبعث من «خطاب كراهية» وتثيرها جملة قوانين غير إنسانية تريد من الفرد الفلسطيني أن يحيا الحصار فيعتاده.. مخيم الدهيشة قرب بيت لحم أحاطه أعداؤه بسياج وكأن أبناؤه مادة خاماً لتجريب أدوات التعذيب واختبارها.. المخيمان يكثفان حنيناً فلسطينياً الى المطرح القديم والأول... حنين عذب وصاف رققته الآلام وطول دربها وجعلته طفولياً حالماً بفردوس مفقود حيث الحق الإنساني والطبيعي في الأرض ما يغذي باستمرار هذا الحلم.
يقوم النسيج الحكائي والبصري المشهدي لـ«أحلام المنفى» في هذه المنطقة.. اختارت المخرجة المصرية الطفلتين «منى ومنار» من مخيمي شاتيلا والدهيشة لتعبرا عن ذلك الحنين.. لقد استعرضت حياتهما العادية والبسيطة واستعرضت أشواقهما الى لقاء على ارض فلسطين المحلوم بها،بعيداً عن المخيم وقسوته بدءاً من اتصال يجري بين الفتاتين وأصدقائهما عبر الإنترنت، ثم يثير تبادل الرسائل مشاعر تتدفأ بالحنين وتنتهي بلقاء على سياج يفصل شمال فلسطين عن جنوب لبنان بعد تحريره ليبلغ الألم ذروته، غناء وبكاء وقلوباً ترف لفتية في طفولتهم المتأخرة. كان هذا المشهد ذروة الشريط ولم يكن نهايته فهو لم ينته، وهو ما يجعل أحلام المنفى مدمرة لاسترخاء المرء في فكرته عن نفسه، إذ كلما حقق قدراً من الفردية العادية وكاد ينتشي بها، فإن الحكاية والألم في اجتماعهما في الصورة يردان المرء الى الجماعة والعيش في الماضي الشخصي الذي يذوب في ماضي الجماعة.
المخيم وأهله في شقائهما عزلتهما الطويلة
البحث عن العدالة، فكرة أساسية في شريط (الحب أصعب.. الحرب أسهل) لسوسن دروزة. البحث عنها بين انعطافتين عميقتين: الانتفاضة الأولى وحرب الخليج ثم انتفاضة الأقصى بعد عشر سنين.
لم تختلف الأسئلة تلك التي طرحها أبو خضر الصالحي، وابنته سهام المهجرين من يافا العام1948 ومن ساكني مخيم الحسين الآن، هو الذي حارب في اللد، وهي الطفلة آنذاك وانتهى بهما المطاف في المخيم حاملين ذكريات موجعة عن الحرب والحب والأمل والبلاد وأهلها.
في روايتهما أمام الكاميرا بدأ الرجل العام 1991 أكثر قوة وعناداً واعتداداً بتاريخه في المقاومة وكذلك أبناء عائلته الصغيرة، التي فقدت اثنين من أبنائها في سلسلة الحروب المتتالية مع جيش الاحتلال في لبنان.
الابنة سهام بدت آنذاك مفعمة بالحيوية والنشاط والقوة. امرأة محاربة بمعنى ما أو تمنح انطباعاً بذلك. إنها على ثقة كبيرة بما تقول وما تطرحه من أسئلة، مدفوعة الى ذلك بقوة الحق التاريخي.
والحال أن طريقة الحديث وما خالطها من يأس في صوت أبو خضر وابنته سهام قد نأت بحال المخيمات عن عرض البؤس، والسعي الى اجتذاب تعاطف العالم، الى الضغط بقوة على مصدر الألم وكشفه للعالم، وقد جاء اختيار لقطات تعرض التهجير القسري بالأبيض والأسود باعتبار هذه اللقطات تخص الأب والابنة، وهي التقاطة ذكية تكررت في أغلب اللقطات.
الكلام الذي دار على فكرة «البحث عن العدالة» ذاتها سيبدو أكثر تأثيراً، علماً أن الشريط برمته يخاطب آخرين.هناك أسباب كثيرة لعرض هذا الألم دون السقوط في شرك الانفعال، او اجترار التعاطف الذي يقود إلى الشفقة.
كبر أبو خضر عشرة أعوام عندما عادت إليه وإلى ابنته سهام المخرجة دروزة وفريق عملها. ثمة سطوة للماضي الذي مر كعاصفة وللحياة التي جرت أمام كاميرا مشاهدها،فيما العالم أغمض عينيه. لم تبق سوى الأمنيات. أبو خضر الذي بات عجوزاً يتمنى، وابنته المرأة التي أصبحت على حواف الأربعين أو في مطلعها،لم يعد شعرها قصيراً فارتدت منديلاً وغطت رأسها. التبدلات في الهيئة تعكس تبدلات عميقة في الشخص ذاته. اختلف أناس المخيم عما كانوا عليه،لكن شيئا حولهم لم يختلف. ما من تغيير سوى السعي اليومي الدؤوب للعيش، كالخروج الى الأسواق ومطارح العمل والحكايا العادية عن ابن أنتهى من الدراسة ولا يجد عملاً أو الابنة المشغولة أمُها بتزويجها. إنهم في عزلتهم الطويلة لا يتحدثون إلا لماماً عن الحب والأشواق الخاصة، الحب الذي من فرط ضغط العيش،كاد ينكسر عصبه في القلوب لولا أنه حاجة إنسانية تفرض نفسها بين لحظة وأخرى.
المخيم في عزلته الطويلة واضح أمام الكاميرا وخلفها في الكلام المنقول عنه بألسنة أهله. يتحرك أناسه داخل تلك العزلة. وتتسابق نشرات أخبار تلفزيونية على نشر الألم الفلسطيني اليومي على حبل غسيل.. الانتفاضة تحدث وتثير الأمل والألم معاً، والمخيم في عزلته الطويلة أمام الشاشة يؤنب نفسه وماضيه على العجز. وهو ما يدفع الى البكاء المر، والصامت، والحارق للروح وللنظر الى العالم، ليس بوصفه غير قادر أو راغب على تحقيق العدالة أو شيء منها. ستون عاماً ظل يختلف الناس فيها ولم يختلف حولهم شيء.
قدمت دروزة تلك المشاهد التي صورتها الكاميرا العام 1991 والعام 2001 على شيء من التداخل والتناظر بين زمنين، وكان على تلك المشاعر أن تصب وتتحول الى ذلك الفضاء المسرحي الذي تجلس فيه الممثلة، نادرة عمران أمام الشاشة، تتابع نشرات الأخبار وتبكي حالها حال أي فلسطيني في العالم أثناء مجزرة جنين مثلاً لا حصراً.
في كلامها وفي جلوسها في مكان خراب وبحركة بسيطة: ربما هي الدمعة وربما هو الضغط على الريموت كونترول، كانت الممثلة تقول الكلام (مخربطاً) و(سيريالياً) تسترده الى واقعيته دون انفعال أو افتعال تلك المشاهد أو ذلك الخراب في المخيم وشخوصه. بدت الممثلة حين انزلقت دمعتها من عينيها مختلطاً بكحلها، كما لو أنها تنزف عصارة دموع الناس في مخيمهم.. شيء أقرب الى الحسرة من تراكم العجز الذي ينمو في الروح، كما تنمو الأعشاب الضارة بين الأشجار.. تقول الممثلة:«لم ننس.. ما في غير الكرسي». ليس غير الخراب تجلس في وسطه، فالألم وصل الى حد الإشباع: هكذا صار الحب أصعب من الحرب بعبارة لنادرة أيضاً. مات أبو خضر بعد إنجاز الشريط بوقت قصير.
| المخيم في ثلاثة شرائط تسجيلية : الحياة تنمو تحت الحطام |
| 15-May-2008 |
| العدد 26 |