

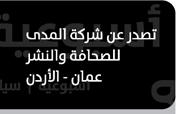
حاوره: حسين نشوان
لم تتعدد انشغالات عز الدين المناصرة بين حقول الشعر والنقد والسينما والتشكيل والفكر فحسب، وإنما تنوعت لديه موانئ الرحيل والمنافي. ولم يكن خياره الأكاديمي بعيدا عن ذلك في دراسة الأدب المقارن، ليصهر كل ذلك في كينونة معرفية ترى في القصيدة نافذة للذات الجمعية.
ولان القصيدة كذلك فإنها تغدو ذاتا صراعية مكافحة ومشاكسة في آن معا، وكل ما يدور حولها يبقى أصداء لتوكيد جوهرها الوجودي والإنساني، فالقصيدة عند الكنعاني كما يحب أن يقدم نفسه هي إعادة إنشاء الذات في تقلباتها وسكونها وحلمها واغترابها، وما بين ذلك من حيوات عاصفة.
صاحب "يا عنب الخليل" و "كنعانياذا"، "النقد الثقافي المقارن"، "علم الشعريات" و "جمرة النص الشعري" صدر له في الشعر عشر مجموعات، بعضها مترجم إلى لغات أجنبية، وعدد من الكتب في النقد السينمائي والتشكيلي والفكري.
وحول قضايا الشعر وتجربته كان هذا الحوار:
بداياتك الشعرية، كانت في مجلّة الأفق الجديد-(1961-1966 ) في القدس، ماذا بقي من هذا الجيل المبدع؟
المناصرة: كانت الأفق الجديد في الستينات، مركزاً مهماً، لتجارب الحداثة الأدبية الفلسطينية-الأردنية، فعلى صفحاتها، ظهر قصاصون وشعراء ومشاريع نقاد، أغنوا الحركة الأدبية آنذاك. طبعاً، بعد ذلك، توقف البعض، وآخرون لم يطوّروا أنفسهم، وبقيت أسماء مهمّة في الشعر، والقصة، حتى الآن. وهذه هي طبيعة الحياة: كل حركة جديدة، يمارس أبناؤها حيويتهم في زمن ما، ثمّ تتلخّص في النهاية في مجموعة رموز. مثلاً: كان صديقي فايز صُيّاغ الكركي الكنعاني، أفضلُنا شعراً، وأكثرنا ثقافة، ولا زلت أتذكر قصائده، وترجماته، لكنّه غاب طويلاً عن الشعر، ليعود إلينا خبيراً في التخطيط، وأصدر مجموعة يتيمة، تركها في اليُتم بلا أخوة أو أخوات. حدث الأمر نفسه لصديقي الطفيلي تيسير سبول، حين أصدر مجموعة شعرية واحدة، ثم هرب إلى الرواية، التي أبدع فيها، ثمّ كانت الفاجعة التي تركت في نفسي أثراً، لا يُمحى أبد الدهر. طبعاً، لقد بقيتْ من (الأفق الجديد) فكرة الحداثة الشعرية، لأنها كانت بالنسبة لنا في الأردن وفلسطين، مشابهةً لمجلة (شعر) اللبنانية، وبقيت في أذهاننا صورة رئيس تحريرها أمين شنّار، الإسلامي الوجودي، والديمقراطي السمح. وبقيت المجموعات الشعرية لزملائنا الأحياء والراحلين.
ألقت القصيدة الفلسطينية بظلالها على الشعر العربي كلّه، لجهة موضوعها، غير أن تأثيرها الفنّي، بقي محدوداً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد لعبت هذه القصيدة دوراً انقلابياً في تناولها للقضايا الكبرى، حيث انقلبت نحو (الذات). فهل يشير ذلك إلى مغادرة الشعر لدوره الجماعي.
ذات مرَّة، كتب قارئٌ في جريدة (النصر) الجزائرية، بعد أن قرأ حواراً معي، نشرتْهُ الجريدة مع صورة لي، كتب يقول: هل يجوز أن تنشروا صورةً لشاعر مقاومة، وكأنه مارلون براندو!!. وذات مرَّة، ألقيت بعض قصائدي المشهورة، أمام جمهور فلسطيني في مخيم "عين الحلوة"، قرب صيدا، ثم أتبعتها بقصيدتين غزليتين، وحين فُتح النقاش للجمهور، قالت سيّدة: "هل يجوز لشاعر ثورة، أن يتكلم في شعره عن إيحاءات جنسية في وصفه لامرأة. حبّذا يا أستاذ، لو حذفت آخر قصيدتين"!!. كان الجمهور، إذن، يُعاقبنا، نحن شعراء المقاومة، إذا خرجنا عن موضوع "الهمّ الجماعي"، بل كان يمارس الرقابة علينا حتى لا "ننحرف"، نحو المواضيع الأخرى. أمّا –النقّاد المحترفون، فهم أكثر خبثاً، لأنهم لجأوا إلى التعميم، وسجنونا في (سجن الفلسطنة)، مع أنّ شعري، مثلاً، يستمد صوره البصرية من كل البلدان التي عشت فيها، سواءٌ في البلدان العربية: (مصر، الأردن، لبنان، تونس، الجزائر)، أو في بلد أجنبي عشتُ فيه خمس سنوات (بلغاريا). فهل يُعقل أن لا تكون قد تسربت في شعري، أية صورة من هذه البلدان. والمسألة ببساطة، أنَّ النقّاد العرب، في دراستهم الفنّية للشعر العربي الحديث، تجاهلوا عامدين، الثورة الجمالية، في الشعر الفلسطيني الحديث في النماذج العُليا من هذا الشعر. صحيحٌ أنه مرّ زمنٌ كان فيه النقاد العرب، والصحف العربية، تتملق وتنافق وتمدح الشعر الفلسطيني، بسمينه وغثّه، حيث لجأت إلى التعميم، لكنّهم تجاهلوا الإضافات الحداثية في نماذج شعرية عالية، عامدين، لأسباب قطرية ضيقة. في كل الأحوال، برز تيار جديد في النقد الأكاديمي، أثبت العكس. لقد صدر أربعة عشر كتاباً نقدياً عن تجربتي الشعرية، لكنّ وسائل الإعلام تتجاهل هذه الدراسات العلمية، لأسباب لا مجال لذكرها.
بعيداً عن التسميات لقصيدة النثر، أو التوصيفات التي قدّمتها في كتابك: (إشكالات قصيدة النثر)، بأنها نصٌّ مفتوح، وجنس أدبي قديم-جديد، هناك من يرى أنّ قصيدة النثر، تقترب من الخطاب الليبرالي في مفرداته، وفاعليته، وصوريته، ووحشيته أحياناً.
هذا لا يتناقض مع وصفي لمرجعيتها الثقافية بأنها (العولمة)، بثورتها التكنولوجية، والجينية، واحتلالاتها، ووحشيتها، وشكلانيتها. لقد نشأت قصيدة النثر في الخمسينات موازيةً لقصيدة الشعر الحرُّ التفعيلي، وليست تطويراً له، فالشعر الحرّ آنذاك، كان هو المتقدم في الحداثة، بينما كانت قصيدة النثر أشبه بِـ (الخواطر الشعرية)، ولم يكن هذان النوعان، قد حصلا على المشروعية عند القرّاء: الشعر الحرّ حصل على مشروعيته الجماهيرية، منذ منتصف الستينات تقريباً. أما قصيدة النثر، فقد كانت مرفوضة، وظلّت في إطار نخبة ضيقة جدا، لكنّها قفزت إلى الصدارة منذ أول التسعينات تقريبا، أي مع صعود العولمة. والعولمة، ليست ليبرالية حقيقية، كما نعرف، فنحن مجرد أسواق للثقافة الاستهلاكية السريعة، وهي ثقافة عابرة مثل فقاقيع الصابون الملوّن، مع أنّ لها متعة خاصة.
قال إدوارد سعيد: (المنفى يمنح المبدع فرصة النظر إلى الأشياء، بحياد). ما الفرق بين (المنفى)، وأنت من ضحاياه، في النص، وفي الواقع.
هناك فارق بين منفى سعيد في أمريكا، ومنفاي في البلدان العربية، وأوروبا الشرقية. فقد عشت حالة مختلفة، هي: (المنفى في المنفى)، ولا أعتقد أن شاعراً فلسطينياً، أو مفكراً مثل إدوارد سعيد، قد عاش مثل تجربتي التي لم أسردها بعد، بينما سردها هو في مذكراته: (خارج المكان). هناك اختلاف في نوعية المنفى. بالنسبة لي، ما زلت مُعلّقاً في الهواء، لا أشعر أن بيتي هو بيتي. وعلى الرغم من كثرة معارفي وأصدقائي وأحبائي في البلدان التي عشت فيها، إلا أنني أشعر أنني ما زلت غريباً وحيداً في هذا العالم المليء بالحركة والضجيج. أمّا (الخليل)، التي أعرفها بيضاء وخضراء ونظيفة من الاحتلال، فقد قيل لي: إنها موجودة في خيالك الشعري فقط، ولو وافق المحتلون الإسرائيليون على عودتك، وهم لم يرفضوا، ولم يوافقوا حتى الآن –فإنك ستعيش غريباً من جديد، فأنا أعيش حالة (المنفى في المنفى).
ثمة صراع خفي، وأحياناً، مُعلن على توصيف الريادة في غير حقل إبداعي، وهناك سباق على المقعد الأول في الشعر. كشاعر وكناقد، ما الذي يحدّد ذلك. هل هو القارئ -الجمهور، أم المؤسسات ووسائل الإعلام.
لا يمكن أن يقبل أيّ شعب، بأن يكون له شاعر أوحد على وزن (الزعيم الأوحد)، فالساحات تتسع لأكثر من شاعر أوحد، عند معظم الشعوب التي تعشق شعراءها. في فرنسا القرن العشرين، يوجد أكثر من خمسة عشر شاعراً عظيماًَ، لكنّ فرنسا – الدولة والشعب، توزع الاهتمام الإعلامي بالعدالة بين شعرائها، معترفة بالتنوع والتعددية النوعية في جامعاتها، ومدارسها، ونواديها. أعتقد جازماً أنّ صناعة النجوم الاصطناعية، مؤقتة، فلا يبقى للشاعر سوى منجزاته النصيّة. أما القصص السياسية والاجتماعية، حول الشاعر، أيّ شاعر، فهي من نوع الفكر الصنمي، الذي تروّج له السلطة، وهذه القصص ستنهار مثل جدار برلين الحديدي لاحقاً. لم يتفق النقاد العرب القدامى على أنّ المتنبي مثلاً، هو الأوّل والأوحد، بل اتفقوا أنه شاعر عظيم مع شعراء عظماء، مثل: البحتري، وأبي تمّام، وامرئ القيس، وأبي العلاء المعرّي، وأبي نواس... الخ، واتفقوا أنه انتهازيّ في السياسة، واتفقوا أن أجمل أشعاره، هي تلك القصائد الوجودية المقهورة، التي تمسّ ذاته النرجسية، حيث نتج عن هذا القهر المتقطع، قصائد تختصر الألم بالحكمة، وأنّ قصائده السياسية، مليئة بالنفاق.
يمثل النقد سلطة سطوة سلطوية- والواضح أنه في العقدين الأخيرين، يبدو محكوماً بالفعل السياسي، الذي يسيطر فيه المركز على الأطراف. ترى، هل أصبح الإبداع مستعمَراً؟
لم يعد هناك مركز ثقافي عربي واحد من الزاوية الثقافية، بعد تدمير المراكز الثقافية الأربعة: (القاهرة، بيروت، بغداد، دمشق)، بوساطة الفعل السياسي، أو العسكري. أمّا (عمّان)، فقد أتيحت لها فرصة ذهبية، لم تقتنصها جيداً، رغم أنها صرفت ملايين الدنانير، لأنّها لم تعط الخبز لخبّازيه الحقيقيين، بل سلّمته لمثقفي المكافآت، ولمبدعي (ثقافة المنسف) الاجتماعية. لهذا فنحن كلّنا أطراف ثقافية من القاهرة إلى بيروت إلى عمّان إلى دمشق... الخ. لقد افتقدت عمّان إلى الحبّ والمعرفة والموضوعية في تعاملها مع مثقفيها الحقيقيين، بل والمثقفين العرب الحقيقيين. وتحوّل (المهرجان) فيها، إلى نكتة سوداء. أما الصحف، وبعض الملاحق الثقافية، فهي تكتب عن مبدع خبراًَ موسعاً في صفحة، لأنه أحيا ندوة هناك، وتناول وجبة في مطعم بلد آخر، ولا تكتب حرفاً عن كتب مهمة، صدرت بالفعل في الأردن، لأن مؤلفيها، لا يجيدون تسويق أنفسهم. أمّا الجامعات، فأخشى أن تتحول إلى "مدارس ابتدائية عُليا". ولكنّني لستُ متشائماً، أو متشائلاً، حسب تعبير صديقي الراحل إميل حبيبي: بالمقاومة الثقافية، يكون الأمل: ومقاومة الفساد الثقافي في البلدان العربية، هي الخطوة الأولى، وعلى الأنظمة أن تعترف بشرعية معارضيها الثقافيين، ما دامت ترفع شعار الديمقراطية، وتزعم أنها أصبحت على يسار الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني. لقد تلاشى الناقد العميق من وسائل الإعلام، وحلّ محلّه المحلّل السياسي، والتغطية الصحافية، والخبر العاجل، وحوارات تلفزيونية منظمة مع مثقفين من الدرجة العاشرة. أما "الجوائز" العربية، فتلك آفة الآفات!!
| الشاعر “الكنعاني” عز الدين المناصرة: ليس هناك ثقافي عربي واحد |
| 13-Mar-2008 |
| العدد 17 |