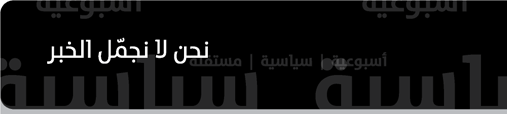

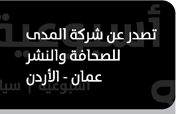
طارق، فتى عشريني يمتلك ماضياً سوداوياً، وحقيبة ذكريات زاخرة بالعنف الأسري، بعد سنوات أمضاها في صراع دموي مع أبيه الذي اعتاد ضرب والدته وإهانتها كلما تجادل الاثنان وتعالت أصواتهما، لتنتهي المشاجرة دائماً بضرب الزوجة وانحسارها باكيةً لغرفتها، قبل أن يسود الحياةَ هدوءٌ نسبي حتى يحين وقت «مشاجرة أخرى» بحسب تعبير الشاب.
في محاولة مستميتة للدفاع عن والدته، كان طارق يرفض «عربدة الأب وظلمه المستمر»، ويبادره بقذف «المخدّات أو الأحذية»، لينتهي به الأمر غالباً مكدوماً ومجروحاً، نتيجة ضرب والده المبرح، والذي اعتاد بعد كل جولة من هذا النوع العودة للمنزل مساء، تعلو وجهه إمارات الندم والمحبة، ملاعباً ابنه وزوجته ليغرقهما بـ«القُبَل والاعتذارات».
«تمثل هذه الممارسات وغيرها عنفاً جسدياً ظاهرياً، ومشاكل نفسية وعاطفية غير بادية للعين المجردة، لعلاقة أسرية غير متوازنة»، يقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية موسى شتيوي، مؤكداً أن عدم معالجة هذه المشاكل والوقوف على أسبابها «يؤدي إلى تفاقمها وتناميها».
منظمة الصحة العالمية عرّفت العنف في سياقه المجتمعي، وكإطار دولي للتعريفات الوطنية للعنف داخل الأسرة العام 2002، بأنه «الاستخدام المتعمد للقوة الجسدية أو القدرة على التهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي والفعلي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي لحدوث أو رجحان حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان».
بدوره، أنجز المجلس الوطني لشؤون الأسرة، دراسة ميدانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نُشرت العام 2008 وشملت 1500 رجل وامرأة أردنيين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ممثلة بعينة تمثل مناطق المملكة كافة.
بينت الدراسة أن إقليم الوسط، والفئة العمرية 58 عاماً فما فوق، أكثر الفئات إدراكاً لمفهوم العنف. وأشارت إلى أن فهم هذه الظاهرة مرتبط بشكل أساسي بالعنف الجسدي بأشكاله المختلفة، وبشدته وتكراره، مع نسب عالية من العينة عدّت ضرب الزوج زوجته وشتمها، أو ضرب الأخ أخته وشتمها في حالات معينة أمراًَ مقبولاً، ما يدل على إضفاء مشروعية على العنف الأسري، مع وجود نسبة ليست بالقليلة من الإناث يَقبلن بأن تُضرب الزوجة أو الأخت، إذ بلغت هذه النسبة نحو 20 في المئة، كذلك فئة 28-37 لضرب الزوجة، وفئة 18-27 لضرب الأخت.
طارق، يؤكد عدم معرفته جوانَب مفهوم العنف كافة، ويرى في الضرب الجسدي الذي كان أبوه يمارسه سلوكاً مبرَّراً: «شقاوتي وتدخُّلي في ما لا يعنيني، كانا يثيران غضبه».
هذا الشاب، وبعد صراع يومي خلف أبواب مغلقة لم يلحظه أحد، دام أكثر من عشر سنوات، تزوج من منى، الحاصلة على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية، طالباً منها ترك العمل، والتفرغ لبيتها وزوجها، فانصاعت لرغباته، رغم تعلقها بالعمل، وتركت حياتها الاجتماعية وصديقاتها «غير الصالحات» بحسب تعبيره، لتدخل حالةً مماثلةً من الصراع، وبسبب «تملّكية» زوجها لها وحرمانه إياها من حقها في حياة أسرية «متوازنة وطبيعية»، أصبحت تعاني من الاكتئاب و«ثورات غضب» قوبلت من زوجها بأشكال مختلفة من العنف.
دراسة المجلس كشفت عن أنواع العنف الأسري الجسدي، مثل اللكم والعض والحرق؛ والانفعالي، مثل الرفض والتحقير والإهمال؛ والنفسي، مثل الإهانة والعزل عن الأهل والأصدقاء؛ والجنسي، مثل الاغتصاب والتحرشات والتعليقات الجنسية المرفوضة، والإساءة الجنسية للطفل بإغرائه أو إجباره على المشاركة في نشاطات جنسية، سواء أكان مدركاً لذلك أم لا؛ والاقتصادي الاجتماعي، مثل حرمان المرأة من تلقي العلم والعمل تحت ذرائع أخلاقية، وحرمان الطفل من حقه في التعليم والرعاية الصحية ودفعه للعمل خارج المنزل.
منظمة الصحة العالمية عدّت العنف الأسري ثالثَ سبب للوفاة بين الناس الذين تراوح أعمارهم بين 15 و44 عاماً في أنحاء العالم المختلفة. وهو مسؤول في العام 2002، عن 14 في المئة من وفيات الذكور، و7 في المئة من وفيات الإناث. أما إدارة حماية الأسرة، فنظرت العام 2004 إلى ظاهرة العنف الأسري بوصفها إحدى أهم المشاكل الاجتماعية عالمياً، لارتباطها بالأسرة، اللبنة الأساسية للمجتمع.
المجلس الوطني لشؤون الأسرة أشار في دراسته، إلى ازدياد حالات العنف الأسري والقضايا التي تعاملت معها، ما فسره شتيوي بازدياد ثقة الناس ومبادرتهم للإبلاغ عن الحالات والمشكلات التي يتعرضون لها.
الباحثون القائمون على الدراسة: شتيوي، فاروق شخاترة، منتهى غرايبة وأروى حداد، عزوا أسباب انتشار العنف الأسري إلى «التوترات الناجمة عن اضطرابات داخل الأسرة، الصعوبات المالية، عدم السيطرة على النفس، الغضب السريع، إضافة إلى تعاطي المخدرات والكحول».
منى تلتقي صديقاتها نادراً، وبغير علم زوجها، خشية الطلاق الذي هددها به في حال خالفت تعليماته. والدتها لاحظت انقلاب ابنتها إلى شخص «هادئ، غير متحدث أو مرح» بعد الزواج، وأن حالتها الآن لا تشي بما تمنّته من سعادة أرادتها لكبرى بناتها، والأولى بينهن في الزواج.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك منير كرادشة، علّق على حالة منى، بوصفها إحدى حالات العنف العاطفي والنفسي والمعنوي التي يندرج تحتها تقييد صداقات الذكور والإناث داخل الأسرة أو حرمانهم من اختيار شريك حياتهم، وعدم السماح للإناث بالعمل، والتدخل في نوع لباسهن أو حرمانهن من المشاركة في المناسبات المختلفة. وعدّه من أقسى أنواع العنف، بسبب صعوبة إثباته قانونياً أو الاعتراف به.
كرادشة أضاف: «تُستخدم في العنف العاطفي وسائل يراد بها طمس شخصية الضحية، وإضعاف قدرتها الجسدية والعقلية، والتهديد والوعيد الدائم، وإحباطها، وإدخالها حالة من القلق الدائم، ما يُحدث تأثيراً سلبياً في حياتها وصحتها النفسية».
تقول منى: «أعرف أنه عانى من ماضٍ مليء بالعنف، لكني أصبحت أعتمد عليه في كل شؤون حياتي»، وتضيف بأسى ملحوظ: «إذا طُلقت فسأغدو وحيدة، ولن يتحملني أي شخص بوصفي امرأة مطلّقة وفي حضني طفل لم يكمل بعد الشهور الثلاثة».
حالة الإنكار وسياسة الصمت هذه ليست بالغريبة، فكثيرون يحاولون جاهدين إنكار وجود ممارسات أسرية تبيح استخدام العنف وتبرره. اختصاصية علم النفس الإرشادي هالة شقم، توضح أن أهم أسباب عدم الإبلاغ عن حالات العنف الأسري هو «الخوف على سمعة الأسرة وتفككها»، مضيفة أن الخوف من زيادة العنف من جانب المعنَّف، وضعف الثقة بالآخرين، والخوف من سجن المعتدي، وعدم ضمان السرية في حال إبلاغ الآخرين، يؤرق كثيرات.
قضية الطفل يزن ذو السنوات الخمس الذي توفي نتيجة تعذيب جسدي قاسٍ على يد أقربائه بعد سجن والده، والتي أثيرت في نيسان/إبريل 2009، أعيد بحثها مؤخراً في وسائل الإعلام، لتكشف عدم وجود إطار تشريعي موحد لقضايا العنف الأسري، إذ يحكمها أكثر من قانون، إضافة إلى الحاجة الماسة لإجراء تعديلات في قانون الحماية من العنف الأسري يفرضها التطبيق العملي، فضلاً عن تعدد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا العنف الأسري من محاكم صلح وادعاء عام ومراكز أمنية وإدارات حماية الأسرة والحكام الإداريين.
لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة على خلفية قضية يزن، أشارت إلى عدم فعالية التعهد الذي يؤخذ من جانب الحاكم الإداري، وعدم وجود أي إجراءات حقيقية لمن لم يلتزم بالتعهد، إضافة إلى عدم وجود آلية متابعة، وأن غالبية التعهدات تتم من قبيل الكفالة المالية والعدلية.
اللجنة كشفت عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالعنف الأسري، وعدم وجود آلية واضحة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العنف الأسري، مع وجود فجوة كبيرة بين التنظير والتطبيق العملي.
الصحفي في الغد موفق كمال، لفت في اتصال مع ے، إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي توصلت إلى عدم وجود نظام فعال للإبلاغ عن حالات العنف الأسري لدى غالبية المؤسسات، والتعامل الفردي مع أي حالة عنف من دون التطرق إلى بقية أفراد الأسرة، إضافة إلى عدم الرجوع للدراسات الاجتماعية السابقة للحالة لدى وجودها، وغياب الشعور الرقابي لدى غالبية هذه المؤسسات بوجود جهة تراقب أعمالها، أو وجود نظام متكامل لتتبع حالة العنف لدى المؤسسات المختلفة، أو دراسات اجتماعية عن الأسرة والأطفال.
كمال قام بتقصي قضية الطفل يزن ضمن عمله الصحفي، وأشار إلى صعوبة تصنيف الحادثة على أنها عنف أسري من زاوية نظر عدد من الجهات المسؤولة، رغم وضوح الإطار الوطني في هذا الخصوص، إذ تُصنف حالات العنف الأسري لدى بعض المؤسسات بوصفها «قضية أساسية»، بينما تراها مؤسسات أخرى «قضية عادية»، مع عدم وجود إطار تشريعي يحدد سبل النهج التشاركي.
القضايا التي يتم الإبلاغ عنها يتم التحقيق فيها بـ«سرية». والعنف الأسري وفقاً للنظرة الدارجة اجتماعياً، أمرٌ من «الخصوصيات»، وتابو لا يتم التداول فيه إلا في جلسات ضيقة، ونادراً، بين أفراد العائلة الواحدة التي لا تكشف عن «غسيلها الوسخ» أمام أحد، كي لا تفتح الباب على عيوب مجتمعية وصراع قوى بين الذكر والأنثى وأصحاب القرار من أفراد العائلة الواحدة، الأمر الذي يستدعي توجه الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لإخراج هذه القضية من دائرة «السريّة»، وبحث الوجوه المحيطة بها بوصفها قضية حق عام أيضاً.
| «يا ما في البيوت مظاليم» العنف الأسري: تابو خلف أبواب مغلقة |
| 01-Mar-2010 |
| العدد 9 |